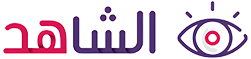انتخابات مجالس الهيئات المحلية وأزمة النظام السياسي

رام الله – الشاهد/ كتب طاهر المصري: يمثّل القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025، بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية محطة جديدة تكشف عمق الأزمة البنيوية التي يمرّ بها النظام السياسي الفلسطيني. فالتعديلات التي أُقرت على القانون، وبخاصة شرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، جاءت لتثير موجة واسعة من الاعتراضات. غير أنّ النقاش حول القانون لم يقتصر على الجوانب الإجرائية، بل امتدّ ليعيد فتح الملفات المؤجّلة حول الشرعية، والمشاركة السياسية، وتوازن القوى، ووظائف مؤسسات الدولة، ودور الفاعلين السياسيين والمجتمعيين.
ورغم حدّة الانتقادات الصادرة عن بعض القوى المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، فإنّ ما طُرح لا يتجاوز إطار المؤتمرات الصحفية وبيانات الاستنكار التقليدية. وهذه القوى، بحكم عضويتها في منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها المركزية ومجلسها المركزي، تمتلك أدوات ضغط سياسية لم تُستخدم؛ من الاعتراض داخل مؤسسات المنظمة، إلى الدعوة لاجتماعات طارئة، إلى تفعيل الأطر الوطنية التي يفترض أنها الحاضنة الجامعة للعمل السياسي، وصولاً إلى تجميد عضويتها في هيئات المنظمة.
لكن الواقع يكشف فجوة بين ما يُعلن وما يُمارس. فهذه القوى تعاني من شيخوخة تنظيمية واضحة، وتراجع في القواعد الشعبية، وغياب فعلي في الشارع، مقابل تشابك مصالح شخصية وحزبية مع الجهات المسيطرة على السلطة والمنظمة. ولعلّ ما يعمّق هذا العجز أنّ بعض هذه القوى لم تعد قادرة أصلاً على فرض مواقف قوية أو ثابتة، إذ تحمل داخلها ملفات خلافية وتجاوزات قد تُستخدم، أو يُلمَّح باستخدامها، كورقة ضغط لاحتوائها أو لتخفيض نبرة خطابها. وفي حالات أخرى، تعتمد فصائل بعينها على موارد وسياقات دعم تجعلها أكثر عرضة للتأثر، وتدفعها إلى تبنّي مواقف وسطية أو مائعة خشية فقدان المكاسب المحدودة المتاحة لها. لقد أصبح كثير من الفاعلين الذين يتصدّرون المشهد جزءاً من شبكة مصالح أوسع، وهو ما يفسّر عدم تحوّل مواقفهم الاعتراضية إلى إجراءات سياسية فاعلة.
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال أن بعض القوى التي أبدت اعتراضها على هذه التعديلات تفعل ذلك بحدود “المسموح به”، وبقدر ما تتيحه علاقتها بالسلطة، أو بحكم حساسيات داخلية تجعلها تتجنب التصعيد الكامل، خشية أن تُفتح عليها ملفات أو تُذكّر بمسؤوليات لم تُحاسب عليها منذ سنوات. فكيف يمكن لقوى بات حضورها الجماهيري شبه معدوم، وتعتمد في ثقلها على رمزية الماضي لا على قوة الحاضر، أن تضغط على السلطة لتعديل قانون له انعكاسات مباشرة على توازنات الحكم المحلي؟ وكيف يمكن لها أن تخوض معركة سياسية حقيقية وهي نفسها عاجزة عن بناء نموذج تنظيمي حديث قادر على تعبئة الرأي العام؟. إنّ المعضلة ليست في التعديلات وحدها، بل في انكشاف هشاشة البنية الحزبية الفلسطينية التي لم تعد قادرة حتى على الدفاع عن حدودها الدنيا.
وعلى خلاف القوى السياسية، قدّم المجتمع المدني موقفاً واضحاً وقوياً، يستند إلى مبادئ قانونية ومعايير حقوقية راسخة. فمؤسساته شدّدت على أنّ شرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية يمسّ جوهرياً الحق في المشاركة السياسية، ويخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال.
ورغم أنّ بعض الانتقادات حاولت تحميل المجتمع المدني مسؤوليات سياسية ليست من اختصاصه، إلا أن الواقع يفرض التمييز بين دورين مختلفين: الأول سياسي–تنظيمي يقع على عاتق الأحزاب والقوى، والثاني حقوقي–رقابي يشكّل جوهر عمل المجتمع المدني. فالمجتمع المدني ليس مطلوباً منه خوض معركة سياسية بالمعنى الحزبي. وظيفته الأساسية هي حماية حقوق المواطنين، وصون قواعد العملية الديمقراطية، ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات. وبالتالي فإن موقفه الرافض للتعديل، وتهديده بإعادة تقييم مشاركته في الرقابة والتوعية والبرامج الانتخابية، يعدّ أقصى ما يمكن أن يُنتظر منه، بل هو موقف مهم يضع خطاً دفاعياً مركزيا في مواجهة التدهور التشريعي.
وما يلفت الانتباه أنّ المجتمع المدني كان الأكثر وضوحاً في تحديد المخاطر القانونية والسياسية للتعديل، مقارنة بقوى سياسية اكتفت بترديد عبارات عامة دون التفات إلى تداعيات أكثر عمقاً، أو إلى الكلفة السياسية التي قد تترتب على صمتها. وبعض هذه القوى، في الواقع، تجد نفسها مقيدة باعتبارات داخلية وحسابات علاقات، تجعلها أقل استعداداً للمواجهة وأكثر ميلاً لخطاب ضبابي يحفظ الحد الأدنى من وجودها.
التعديل الخاص بشرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير قد يفتح الباب أمام احتمالات سياسية خطيرة لم تُناقش بجدية. فالمسألة ليست مجرد شرط رمزي، بل قد تتحوّل، في إحدى قراءاتها السياسية، إلى بوابة لإعادة إنتاج نموذج “روابط القرى” أو أشكال جديدة من الإدارة المحلية ذات شرعية سياسية محلية منفصلة عن الإطار الوطني الجامع. وعندما يتحوّل المنتخبون في البلديات إلى أصحاب “مشروعية سياسية” مستمدة من التزامهم ببرنامج يعتبر مرجعية وطنية، فإنهم لا يعودون مجرد ممثلين خدماتيين، بل فاعلين سياسيين يمتلكون الحق، ولو نظرياً، في التعبير والتحرك والتفاوض المحلي والدولي باسم البلديات.
وهذا قد يؤدي إلى نقل جزء من التمثيل السياسي من منظمة التحرير الفلسطينية إلى البلديات بحكم الواقع لا بحكم القانون؛ وإلى تعزيز توجهات بعض الجهات الدولية والإقليمية للتعامل مع البلديات كأجسام تمثيلية بديلة؛ وإلى خلق اتحادات بلديات ذات طابع سياسي قد تطالب لاحقاً بدور يتجاوز حدود الشأن المحلي. وقد يمنح هذا النموذج الإدارة المدنية في سلطة الاحتلال ذريعة للتعامل مع البلديات كبديل عن المؤسسات الوطنية. هذه السيناريوهات، إن لم تكن حتمية، فهي واقعية وقابلة للتحقق في ظل هشاشة البنية السياسية الفلسطينية، وانقسام النظام السياسي، وتراجع وظائف المنظمة، واتساع الفجوة بين المؤسسة الرسمية والقوى والأحزاب السياسية والمجتمع.
القانون المعدّل بشأن انتخابات الحكم المحلي ليس مجرد نص تشريعي. إنه مرآة للأزمة الفلسطينية الشاملة؛ أزمة ثقة، وأزمة شرعية، وأزمة تمثيل، وأزمة أحزاب عاجزة، ومجتمع مدني يحاول ما استطاع، وسلطة تتخذ قرارات في فراغ سياسي. المطلوب ليس مؤتمرات صحفية، ولا بيانات استنكار موسمية، بل إعادة بناء معادلة القوة السياسية التي تسمح بمساءلة السلطة، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، واستعادة الحياة الديمقراطية من جذورها.
أما إذا بقي المشهد على ما هو عليه، فإن التعديلات القانونية لن تكون سوى خطوة جديدة في مسار التفكّك البطيء للتمثيل الوطني، وانزلاقاً نحو نماذج حكم محلي تحمل مشروعية سياسية غير مضبوطة، وقد تنتهي، بقصد أو دون قصد، إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية خارج إطار المنظمة التي من المفترض أن تبقى الوطن المعنوي والهوية الجامعة للكل الفلسطيني.
إنّ النقاش حول تعديلات قانون الحكم المحلي، وما يرافقه من تآكل قدرة القوى السياسية على التأثير، وارتفاع صوت المجتمع المدني في الفراغ، وانتخابات تُدار في بيئتين سياسيتين منفصلتين؛ بين ضفة تعيش تهجيراً قسرياً صامتاً ونظام فصل عنصري يفرض قيوداً يومية على الحياة، وقطاعٍ يرزح تحت حرب إبادة حقيقية تمنع أي مسار انتخابي، يكشف أن الفلسطينيين ليسوا أمام أزمة عابرة، بل أمام تحوّل بنيوي يهدد معنى التمثيل الوطني ذاته ويقوض أي فرصة لإنتاج مشروع سياسي موحّد. فالأزمة لم تعد محصورة في نصوص قانونية، ولا في أداء سلطة هنا أو فصيل هناك؛ بل أصبحت أزمة كيان سياسي ينهار من الداخل، ويفقد أدوات تنظيمه، وروافع وحدته، ومسارات تجديده، بينما تتسع دائرة التهميش والضعف أمام احتلال مستمر وإبادة ممنهجة للأرض والشعب.
لقد أصبح الهمّ الفلسطيني اليوم مركّباً بين احتلال يتعمّق ويعيد تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا؛ وسلطة مُقيده؛ وقوى سياسية تتآكل من الداخل؛ ومنظمة تحرير فقدت مركزيتهاالتمثيلية؛ وانقسام يتجذر في الوعي قبل المؤسسات. وفي ظل هذا المشهد، تتحوّل التعديلات القانونية إلى مؤشرات إنذار مبكر على لحظة قد يصبح فيها النظام السياسي غير قادر على إنتاج ذاته، أو تجديد نخبته، أو بناء توافقاته الدنيا.
إنّ تجاوز هذا الانهيار البطيء لا يمكن أن يتحقق عبر إلغاء تعديل قانوني، ولا عبر بيانات سياسية موسمية؛ بل عبر إعادة بناء مشروع وطني جامع، يعيد تحديد شكل وطبيعة العلاقة ما بين المنظمة والسلطة، ويعيد الاعتبار للمشاركة السياسية الحقيقية، وللعمل الجماعي القادر على مواجهة الاحتلال لا إدارة الانقسام.
وإذا لم يُفتح هذا الأفق قريباً، وظلّت القرارات تُصاغ بمنطق الحسابات الضيقة، فإن الفلسطينيين سيجدون أنفسهم أمام فراغ وطني يتوسع، ونظام سياسي يتقلّص، وخريطة أمر واقع تتمدد على حساب فكرة الوطن ذاته.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=97736