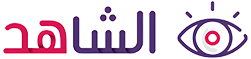هل يحل ترامب السلطة الفلسطينية؟

رام الله – الشاهد| اختتم ترامب فترته الرئاسية الأولى بعلاقة شبه مقطوعة مع السلطة الفلسطينية؛ تعمّد خلالها تهميش دور السلطة في أي خطوة متخذة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والتضييق على مساعداتها المالية وقطع العلاقة الدبلوماسية معها. وبرغم هذه التضييقات غير المسبوقة أمريكياً حيث لم تعد السلطة مهما قدمت من فروض الطاعة شريكةً مرغوبة “للسلام”، ألا أن الفترة الرئاسية الحالية التي لم يمر على إنطلاقها سوى أشهرٍ قليلة تشهد نوعاً جديداً من التوتر الأمريكي مع السلطة؛ إذ يبدو أن حدّة الإجراءات المتخذة في مواجهة السلطة ورجالاتها تسعى إلى سحب صفتها التمثيلية الدولية؛ حيث لا يمكن النظر لهذه الإجراءات في معزل عن حرب الإبادة الطاحنة التي يتعرض لها قطاع غزة ومخططات الضم التي تسير على قدم وساق وبمباركة أمريكية في الضفة الغربية.
فما هي حدود علاقة ترامب بالسلطة الفلسطينية؟ كيف عمل التهميش الممنهج على تقزيم دور السلطة على الأرض؟ وكيف سعت الأخيرة لتدارك الموقف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ كيف أثر غياب العلاقة الدبلوماسية بين الطرفين على الفلسطيني؟ وأي معنىً يحمله وصم السلطة بالإرهاب؟ هل يسعى ترامب لسحب الصفة التمثيلية للسلطة والإحتفاظ بها مكتب تنسيق أمني؟ يحاول هذ المقال الإجابة عن هذه الاسئلة وغيرها.
التهميش الممنهج: أول الرقص حنجلة
في الأشهر الأولى لفترته الرئاسية السابقة، جمعت ترامب علاقات ودية بمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، كان عنوانها تفاهمات حول دور السلطة الأمني في الضفة الغربية. غير أن إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، في اعتراف ضمني بحق إسرائيل في المدينة المقدسة كعاصمة لها، وترت العلاقات بين الطرفين ونجم عن رفض السلطة الخضوع لهذه الخطوة ومواصلة العلاقة بناء عليها، قطعاً للقنوات الدبلوماسية بين الطرفين بإغلاق للممثلية الفلسطينية في واشنطن إضافة لقطع المساعدات والتمويل الأمريكي لمؤسسات السلطة.
لكن سرعان ما تغيّر الحال؛ إذ على مدار أعوام حكم ترامب لم تكن السلطة الفلسطينية شريكاً في مخططاته سواء تلك المتعلقة بالضفة الغربية (صفقة القرن) أو بقطاع غزة (ريفيرا غزة). بل على العكس من ذلك؛ فقد تعمّد ترامب في فترتيه الرئاسيتين أن يتجاوز مبدأ “حل الدولتين” الذي يضمن للسلطة الفلسطينية استمراريتها ودورها الوظيفي والتمثيلي. مؤكداً أن دولة فلسطينية تعني مكافأة للإرهاب في إشارة لنفيه إمكانية تتويج جهود السلطة بالإعتراف الدولي.
فإبان فترته الرئاسية الأولى، دقّت صفقة القرن المسمار الأول في نعش السلطة الفلسطينية؛ فلا أرض ولا سيادة ولا استقلالية ولا مبرر وجود. ولم يكن الدور الخدماتي الضئيل للسلطة وفقاً لصفقة القرن فخاً مخبأً بقدر ما كان مطروحاً علانية على طاولة واشنطن؛ فما يعرف بخطة السلام والإزدهار طرحت مباشرة دوراً محدوداً للسطلة الفلسطينية تعمل فيها كوكيل أمني لملاحقة جيوب المقاومة في الضفة بينما لا تمتلك سلاحاً ولا حكماً ذاتياً ولا سيطرة على حدود برية ولا بحرية ولا جوية.
الصفقة المستوحاة من خطة “القطرات” التي وضعتها المنظمة الصهيونية العالمية عام 1979 لا تملك أي تصوّر لدورٍ فلسطيني تمثيلي حينها، كما ولم تشهد تعديلاً محورياً لدى إعادة طرحها إبان فترة ترامب الرئاسية الأولى؛ إذ تحولت الضفة الغربية بموجبها إلى مجرد جزر معزولة تربطها جسور وأنفاق تحت سيطرة أمنية إسرائيلية وبأقل التكاليف بحيث يضطلع الفلسطينيون بخدمة أنفسهم بدلاً من أن يتكلف محتلهم بظروف معيشتهم وفقاً لقواعد القانون الدولي كأرخص إحتلال عرفه التاريخ المعاصر.
ريفيرا غزة من ناحية أخرى؛ لم يبق للسلطة أي أمل بحكم القطاع في “اليوم التالي للحرب” كأن القطاع سُلِخ عن الأرض الفلسطينية التي تطالب السلطة بها في المحافل الدولية في دعوة للتطهير العرقي ونزع الصفة العربية عن الأرض وتكريس ما يُعرف بحل الدولة الواحدة والذي لطالما نال إعجاب ترامب وتقدّم لديه على الدولتين بحيث ان الدولة الواحدة عنده هي إسرائيل متسعة بقدر ما تسمح لها الجغرافيا ومنفردة بالحكم والسيادة وآمنة بسواعد وكلائها العرب في الداخل الفلسطيني والمحيط العربي.
وقد قاومت الإدارات الأمريكية المختلفة طويلاً مقترحات للسلطة بحكم غزة في مقابل دعم واشنطن لحل الدولتين وآخرها مقترحات حل أزمة يوم التالي لحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع؛ إذ يبدو أن واشنطن فضّلت الإحتفاظ بحالة من عدم الإستقرار والعزلة الدولية لقطاع غزة في ظل حكومة إسلامية يرفضها الغرب عامة على منح مزيد من الأرض لجهة تحمل نوعاً من التمثيل الدولي وتلقى قبولاً في الأوساط الأوروبية والعربية على السواء متحججة بفساد أجهزة السلطة وتحريضها الخفي على إسرائيل وهي شمّاعة ما فتأت واشنطن تستخدمها مهما قدّمت السلطة من فروض الطاعة ودفعت عن نفسها التهم بمزيد من التعاون والتسليم.
الدول العربية هي الأخرى تخطت السلطة الفلسطينية في تحركاتها المتعلقة بحكم قطاع غزة بعد الحرب؛ فمن تغيب قوى فاعلة مثل الإمارات والسعودية عن اجتماعات القادة العرب التي حضرتها السلطة الفلسطينية كإجتماع فبراير الذي تلى إعلان ترامب عن خطة الريفيرا، إلى عقد إجتماعات تستثني السلطة لبحث مستقبل القطاع كإجتماع السعودية وقطر ومصر والإمارات عقب الإعلان أيضاً، وصولاً إلى خطط عربية لإدارة القطاع بإدارة مؤقت خطة مصر، لم يبدو ان أياً من شركاء واشنطن في المنطقة معنيّ بوجود السلطة ولعبها دوراً مؤثراً في إدارة القطاع.
على خلاف بايدن، لم يهتم ترامب يوماً بإصلاح السلطة الفلسطينية بل سعى لإستخدامها كبيدق أمني في الورقة الفلسطينية. الامر الذي دق نواقيس الخطر لدى السلطة الفلسطينية؛ حيث أنتج تهميش ترامب للسلطة في خطة الريفيرا؛ ومن ثم تهميش حلفائه من القوى السنية في المنطقة وخاصة المملكة العربية السعودية، تحركاً عاجلاً في صفوف السلطة. إذ ما إن عقدت الجامعة العربية قمتها الطارئة حتى أعلن عباس عن تعيين حسين الشيخ، المرغوب امريكياً، كنائب له. إضافة لإعلانه العفو الرئاسي عن المفصولين من حركة فتح وعلى رأسهم دحلان، المرغوب خليجياً. خطوة مرة أخرى لم تثنِ ترامب عن مخططاته التي تستثني السلطة جملة وتفصيلاً من الحكم الفعلي والتمثيل الدولي.
وأخيراً؛ جاء التفاوض الأمريكي المباشر مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في القطاع؛ حيث مثّل صفعة للسلطة الفلسطينية التي تصر على استثناء الحركة من حكم قطاع غزة بعد الحرب بحجة عزلتها الدبلوماسية والدولية وتبنيها لنهج تعتبره واشنطن إرهابياً ولا يمكن التواصل معه. وقد رأى اليسار الإسرائيلي في تجاهل ترامب للسلطة ومعاقبة رجالاتها ومؤسساتها هدية لحماس في إشارة لعواقب قتل مبدأ حل الدولتين على السلطة الفلسطينية.
الميل مع إتجاه الريح
ما إن لاحت بالأفق إحتمالية عودة ترامب للبيت الأبيض قبيل الإنتخابات الأمريكية الأخيرة حتى بدأت السلطة الفلسطينية بسلسلة خطوات لإستعادة ثقة ترامب وتلافي الفجوة التي حدثت بين الطرفين إبان فترته الرئاسية الأولى. فقد شنت السلطة الفلسطينية حملة قمع عنيفة ضد مخيمات طوباس وجنين شمال الضفة الغربية نهاية عام 2024 في محاولة للجم المقاومة الفلسطينية المتنامية فيها.
كما أعلن محمود عباس فبراير الماضي امتثال السلطة لقانون تايلور فورس 2017 الذي يمنع الكونجرس من تمويل السلطة طالما تقوم بالدفع لمرتكبي “جرائم إرهابية” ضد الإسرائيليين سواء كانوا أسرى أو عوائل شهداء نفذوا عمليات ضد الإسرائيليين. وقد كانت هذه المسألة تشكّل نقطة خلاف محتدمة بين السلطة الفلسطينية والإدارات الامريكية المتعاقبة الجمهورية منها والديمقراطية. وبينما كانت السلطة تخشى فيما مضى رد الفعل الشعبي على قطع مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء؛ توصلت أخيراً قبيل تولي ترامب لولايته الثانية بقليل لخطة تقتضي الإمتثال للمطالب الأمريكية وأعلنت مع أول شهر له في البيت الأبيض نقل نظام الدفع المخصص للأسرى والشهداء لبرنامج الرعاية الإجتماعية القائمة على الحاجة المالية لنزع البعد الوطني والسياسي عنها والإحتفاظ بها كجزء من الخدمات الإجتماعية للنظام الحاكم.
وقد امتثلت السلطة بالحرف لمتطلبات قانون تايلور فورس القاضية بإدانة ما تسميه بالعمليات الإرهابية بشكل علني ومباشر؛ إذ في آخر عملية شنتها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية: عملية القدس التي وقعت في سبتمبر الجاري؛ سارعت السلطة الفلسطينية لإدانة ما أسمته بالهجوم الإرهابي على المدنيين.
تعلمت السلطة درسها الصعب من أزمة نقل السفارة 2017؛ فقد اختلف رد فعلها على خطة ترامب لليوم التالي للحرب تحت عنوان “ريفيرا غزة”. لم تلجأ للرفض المباشر والتحدي؛ بل إختبأت وراء رد فعل عربي جماعي بالرفض على أمل أن لا تضطر لقطع العلاقات الأحادية إلى حد بعيد إذا ما تواصل إصرار ترامب على تنفيذ خطته. من جهة أخرى، ظل اللعب مع ترامب بعيد إعلان خطته في الظل حتى لا تتهم السلطة بالتواطؤ المباشر.
الدبلوماسية المفقودة: محو الفلسطيني
لم تكن خطوة إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن وقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطة إبان فترة حكم ترامب الأولى مجرد فركة أذن على رفض صفقة القرن والإعتراض على خطة نقل السفارة الأمريكية لتل أبيب إلى مدينة القدس؛ إذ ما إن عاد ترامب للبيت الابيض حتى أغلق مكتب الخدمات الأمريكي OPA الذي افتتحه بايدن لخدمة الفلسطينيين في القدس الشرقية وضمه لسفارته لتل ابيب في إمعان بقطع العلاقات الدبلوماسية ونفي الصفة الدولية عن الفلسطينيين.
وقد أثر غياب القناة الدبلوماسية بين واشنطن والسلطة على الفلسطيني في الداخل والخارج على السواء؛ فعدا عن أنّ أي من مخططات ترامب لم تلق بالاً للسيادة الفلسطينية بل ورفضتها جملة وتفصيلاً معتبرةً إياها تهديداً نوعيا للسيادة والأمن الإسرائيليين؛ فإن إدارة ترامب دأبت على التعامل مع الفلسطينيين كمعدومي الجنسية في نفي فعلي لدور السلطة التمثيلي والمنظمة من قبلها وسحب لبساط أوسلو الذي ما زالت السلطة تتمسك به. وقد ثبتت هذه الواقعة في عدد من التحركات الداخلية الامريكية والدبلوماسية وحتى التصريحات الرئاسية.
فقد أزال ترامب من موقع وزارة الخارجية الأمريكية مسمى “الأراضي الفلسطينية” ولم يعد بإمكان الفلسطينيين ذكرها في طلباتهم ومعاملاتهم الأمريكية، كما لم يعد بالإمكان تسميتها في المساعدات الأمريكية أو التحركات السياسية والدبلوماسية الداخلية. في المقابل، رفض رفضاً قاطعاً حق العودة لفلسطيني المهجر والشتات وتمسك بحل التوطين في البلاد التي لجؤوا إليها.
مؤخراً، تأتي خطوة إلغاء التاشيرات الدبلوماسية الممنوحة لممثلي السلطة الفلسطينية لحضور إجتماعات الجمعية العامة المزمع إقامتها في مقرها في مدينة نيويورك خلال شهر سبتمبر الجاري تأكيداً على عدم رغبة إدارة ترامب بتمتع السلطة الفلسطينية بصفة تمثيلية دولية مؤثرة في الخارج ووقوفها على قدم المساواة مع سلطات الحكم في العالم الحر.
فالتبريرات التي ساقها وزير خارجية ترامب ماكو روبيو لإلغاء التاشيرات تبدو مفرغةً من معناها بإستثناء التحركات الدولية للإعتراف بدولة فلسطينية. فمن طلبه إدانة ما أسماه بالإرهاب بما في ذلك عملية السابع من اكتوبر وحتى تغيير المناهج الفلسطينية ووصولاً لوقف التحركات القانونية في محكمة الجنايات الدولية؛ يبدو أن روبيو لم يلحظ ان السلطة قد سبقته بخطوة. فالإدانة لطوفان الاقصى ولكل تحركات المقاومة في القطاع وفي الضفة علنية ومكررة على ألسنة رجالات السلطة. بل إنّ المقاومة كانت كبش فداء واساس تحركات السلطة في أوروبا لجني إعتراف بالدولة الفلسطينية تضمن لها بقاءها في الحكم؛ إذ أدان محمود عباس في رسالته الموجهة لماكرون حزيران الماضي عملية السابع من أكتوبر وطالب بتحرير “الرهائن” فوراً دلالة على نبذ سلطة رام الله لما يعتبره الغرب “إرهاباً”.
والمنهاج الفلسطينية الحالية تكاد تخلو من آيات الجهاد والشهادة وسير المناضلين خاصة بعد حملة التعديلات التي شنتها السلطة على المناهج الفلسطينية 2016-2017 مع بدايات الضغط وقطع التمويل من إدارة ترامب الأولى والكونجرس حينها. أما القضية المرفوعة أمام محكمة الجنايات الدولية فهي مجمدة منذ أمد طويل ولم تكد بعد تولي كريم خان منصب المدعي العام للمحكمة خلفاً لفاتو بنسودا تتحرك قيد أنملة. والسلطة نفسها لم تعد القضية ضمن جدول اولوياتها وهي تناضل الآن في حرب وجود مع إدارة ترامب الحالية.
يبقى المبرر الأخير الذي اعتبره روبيو مخالفاً للقوانين والأعراف الأمريكية ومكافئاً للإرهاب وهو مساعي الإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من قبل حكومات غربية وأوروبية أبرزها كندا، إستراليا، بريطانيا وفرنسا؛ الامر الذي تدرك السلطة الفلسطينية أن في التراجع عنه إطلاقاً للنار على قدميها وسحباً لآخر فرصها للحكم والتمثيل الدوليين. رغم أن تحرك روبيو ذاته يأتي مخالفاً للإتفاق الموقع بين واشنطن والأمم المتحدة عام 1947 والذي يلزم واشنطن بمنح تأشيرات دخول أراضيها للوفود الدبلوماسية لحضور إجتماعات الجمعية العامة في مقرها في مدينة نيويورك.
صفة الإرهاب: القضاء في خدمة ترامب
لم تستقل إدارة ترامب في محاصرة السلطة وسحب البساط من تحت قدميها منذ مطلع العام الحالي؛ فقد تظافرت معها محكمة النقض الأمريكية أعلى سلطة قضائية في البلاد والتي يسيطر عليها الجمهوريون بواقع 6 قضاة مقابل 3 ديمقراطيين. ففي العشرين من حزيران الماضي أصدرت المحكمة بالإجماع قراراً يتيح للرعايا الامريكيين المتضريين من عمليات المقاومة في إسرائيل والأراضي المحتلة مقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على “أفعال الإرهاب”.
يأتي قرار المحكمة في قضية فلد ضد منظمة التحرير الفلسطينية، متماشياً مع قانون الكونجرس لعام 2019، في ظل إدارة ترامب الأولى، وهو قانون “تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب “PSJVTA. والذي يمنح المحاكم الأمريكية سلطة نظر القضايا المرفوعة على السلطة والمنظمة والتي تتضمن أفعال الإرهاب المنسوبة للفلسطينيين. إضافة لكل من قانون تايلور فورس الذي يحرم السلطة من بعض التمويل لدفعها مستحقات الاسرى والشهداء وسياسة “إدفع من أجل القتل” التي استحدثتها واشنطن لمعاقبة السلطة على تحويل تلك المستحقات.
المحكمة غضّت الطرف عن مسألة ما إذا كانت السلطة الفلسطينية تمثّل طرفاً دولياً يملك سيادةً على أراضيه وشعبه، في تماشٍ مع سياسة واشنطن الرافضة للبت في المسألة، ولكنها لم تقم أيضاً بتسمية السلطة ب”منظمة إرهابية أجنبية” FTO وهو مسمىً يتبعه قطع كلي للعلاقات مع السلطة، تاركةً بذلك هامشاً للإدارة الأمريكية للتحرك بما يوافق مصالحها ومصالح إسرائيل مع السلطة.
الحكم جاء مفاجئاً في توقيت حرج ومهّد لقرار روبيو بحرمان وفد السلطة من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة لحضور جلسات الأمم المتحدة. إذ أن المحكمة لطالما نأت بنفسها عن إنصاف الضحايا الفلسطينيين أو المؤيدين للحق الفلسطيني من الذين يحملون جنسيتها بدعوى خروج المسألة عن صلاحياتها وإنضوائها تحت لواء أعمال السيادة التي تنفرد بها الإدارة الامريكية دوناً عن السلطة القضائية. الحكم يأتي إقراراً واقعياً بصفة السلطة كقائمة بأعمال الإرهاب وإن لم يصمها بذلك بشكل علني ومباشر.
التنسيق الأمني مقدس عند الجميع
لا تخلط واشنطن الأوراق؛ فالدور الأمني للسلطة الفلسطينية محوري بالنسبة لترامب وهو متوجه بشدّة لتقديمه على ما سواه من أدوار تلعبها السلطة على الساحة الفلسطينية. من ناحية هناك ورقة التمويل الأمريكي التي حتى في أحلك ظروفها إبان فترة الإدارة الأولى لترامب لم تتوقف عن تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية؛ في حين قطع ترامب عام 2018 كافة المساعدات الأمريكية لمؤسسات السلطة الأخرى بما فيها 230 مليون دولار متوجهة للتنمية الإقتصادية في الضفة والقطاع، 25 مليون منها مخصصة لمستشفيات القدس الشرقية، و360 مليون دولار أخرى مخصصة للأونوروا.
وحتى بعد أن أعلن ترامب إبان فترته الرئاسية الثانية، فبراير الماضي تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج الUSAID بصورة عالمية، بما يشمل مخصصات الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ حافظت واشنطن على قنوات التمويل الاخرى التي تضمن تدفق الأموال والتدريبات والمعدات لتلك الأجهزة. فقد تقدمت وكالات المخابرات المركزي CIA لتمويل الأجهزة، كما تابعت وزارة الخارجية تمويلها من خلال برنامج مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون INCLE.
وهذه القنوات تم استخدامها بطلب من إسرائيل؛ إبان إدارات ترامب وبايدن واوباما، في كل مرة كانت واشنطن تقطع المساعدات الموجّهة للشعب الفلسطيني ومؤسساته وخطط التنمية والبنية التحتية وبرامجه الصحية والتعليمية. كان التمويل الامريكي الجانبي يحافظ على تدفقه لأجهزة الأمن للحفاظ على دورها الأمني في الضفة دون سواه.
ومن ناحية أخرى هناك التدريب والإشراف الأمريكي المباشر على هذه الأجهزة والذي يلعبه دوره الرئيس مكتب المنسق الأمني الامريكي الذي تم إنشاؤه في بدايات تولي محمود عباس لرئاسة السلطة أيام إدارة بوش. وقد لعب هذا المكتب، إضافة لمجلس الامن الأمريكي، دوراً مهماً في تنسيق العمليات العسكرية التي شنتها السلطة على مخيمات جنين وطوباس بداية العام الجاري. ورغم تهديدات إدارة ترامب بإلغاء المكتب إمعاناً منها بتهميش السلطة ورفض أي دور لها؛ تراجعت الإدارة مؤخراً عن تلك الخطوة وأسندت مهمة متابعته لمايك هاكابي، سفير ترامب لإسرائيل، بدلاً من ماركو روبيو وزير الخارجية، كما كان الأصل منذ عام 2005. ويأتي هذا التغيير في إشارة لضم السلطة كجهازٍ أمني مربوط بإسرائيل بدلاً من كونها طرفاً ندّاً في المعادلة أمام الأمريكي الوسيط.
وحتى بعد أن ضاعفت إسرائيل من علمياتها العسكرية في الضفة الغربية؛ ما زالت واشنطن تسعى لتمكين الدور الأمني للسلطة الفلسطينية لإداركها بأهميته على المدى الطويل لإستقرار الضفة الغربية وأمن إسرائيل.
ختاماً؛ في كتابها “تاريخ قصير لقطاع غزة” ترى آنا عرفان، محاضرة الجندر والعرق ودراسات الإستعمار في جامعة لندن، أن نهج ترامب بتهميش السلطة وقص أجنحتها وتقليم أظافرها، يأتي تتويجاً لجهود ونوايا الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ كلينتون الذي أنشأ السلطة بموجب اتفاقيات أوسلو. وأنّ الدور الأمني المحدود الذي تلعبه السلطة بعرف ترامب ومخططاته ليس إلا تأطيراً لدورها الاساس الذي تريده واشنطن منذ البدايات المبكرة حيث الصفة التمثيلية الدولية هي مجرد شبّ عن الطوق يستدعي تأديباً عاجلاً.
وعليه يبدو أن أي توجه للتحرر الجزئي والإستقلال ولو الورقي بإعلان سيادة مفرغة من معناها على الضفة المسلوبة والقطاع المدمّر سيقابل بغضب أمريكي وعقوبات تتراوح بين التهميش وتجميد المعونات وقد تصل مستقبلاً إلى حد إعلان حل السلطة وتحجيم دور رجالاتها في مكاتب أمنية وخدماتية تابعة لتل أبيب بالكلية تحمل عنها عبء الإدارة المدنية وتذود عن حماها دون أن تمتلك رفاهية التمثيل الدولي والتحدث على المنابر.
المصدر: نون بوست
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=94281