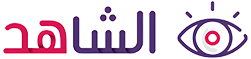إصلاح على مقاس الغرب وليس الشعب

رام الله – الشاهد| خط الكاتب الفلسطيني نبهان خريشة مقالاً حول مزاعم الإصلاح التي تروجها له السلطة الفلسطينية، والتي اعتبرها أنها محاولة لكسب رضا الغرب والممولين وليس من أجل الإصلاح والشعب، وفيما يلي نص المقال كاملاً.
بينما تجري نقاشات مكثفة حول مستقبل السلطة الفلسطينية ومصير مشروع «الإصلاح» الذي يُعاد تدويره في كل مناسبة، تتكشف الحقيقة بوضوح: ما يُسمّى بالإصلاح ليس نتاجاً لتحولات داخلية ولا استجابة فعلية لمطالب المجتمع الفلسطيني، بقدر ما هو انعكاس لضغوط خارجية، وإملاءات من الممولين، ومحاولة دائمة لتجميل واقع سياسي متآكل دون المساس بجوهره. فالإصلاح الذي يأتي مفروضاً من الخارج، أو مصمماً ليناسب مقاس القوى الدولية التي تتحدث عن «إحياء حل الدولتين»، لا يمكن أن يكون إصلاحاً حقيقياً، ولا يمكن أن يكون معبّراً عن الإرادة الشعبية التي باتت ترى في السلطة الفلسطينية نظاما يعيد إنتاج نفسه لا أكثر.
لقد أصبح جلياً أن الحديث المتكرر عن إصلاح النظام السياسي الفلسطيني ليس سوى خطاب للاستهلاك الدولي، يُطرح حين تتزايد الضغوط أو حين تحتاج السلطة إلى إعادة تثبيت شرعيتها أمام داعميها الغربيين. المجتمع الفلسطيني ومكوناته السياسية والاجتماعية لم يكونوا في أي لحظة الطرف المقرر في هذه العملية، رغم أنهم الطرف الأكثر تأثراً بنتائجها. فالقوى الدولية التي تربط الدعم المالي بإجراءات «إصلاحية» هي نفسها التي تحدد أولويات هذا «الإصلاح»، بما يضمن استمرارية التنسيق الأمني، وتقييد أي تحولات سياسية قد تُفضي إلى بنية قيادية جديدة، أو إلى نظام أكثر تمثيلاً وشمولاً. وبذلك، يتحول الإصلاح إلى مشروع أمني وإداري خارجي، لا علاقة له بحاجات الناس ولا بطموحاتهم، بل يُعاد تشكيله كلما تغيّرت أجندات الممولين أو تراجعت فرص إحياء مسار سياسي متعثر منذ عقود.
وبينما يكرر الرئيس محمود عباس ومسؤولون آخرون تصريحاً بعد آخر بأن «الإصلاح يسير على قدم وساق»، تكشف الوقائع اليومية أن المعالجة نفسها تُدار بنفس الأدوات القديمة، وبنفس العقلية التي ترفض المساءلة والشفافية. فمثلا قضية مسؤول المعابر الذي لاحقته اتهامات الفساد انتهت بمنحه مكافأة مقنّعة عبر إحالته إلى التقاعد، وكأن التقاعد ليس وسيلة لإخراج ملفات محرجة من التداول العام. لم تُفتح تحقيقات شفافة، لم تُقدَّم نتائج للرأي العام، ولم يظهر أي مؤشر على إرادة لمحاسبة حقيقية. أما وزير النقل والمواصلات الذي ضجّت مواقع التواصل بقضيته، وتحدث المواطنون والكوادر الإدارية عن شبهات خطيرة تتعلق بإدارته وقراراته، فقد انتهى الأمر بإقالته فقط، دون بيان واضح أو رواية رسمية تُفسر للرأي العام ماذا حدث ولماذا. حلّ وزير جديد مكانه، وبقيت القضية الأساسية في الأدراج، وكأن الإقالة وحدها كافية لغلق الملف أو محو أثره من الذاكرة العامة.
هذه الممارسات ليست استثناءً عابراً، بل جزء من منظومة حكم يتركز فيها كل شيء بيد الرئيس. السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية باتت عملياً بيده، وهو ما انعكس في عشرات القرارات التي صدرت تحت مسمى «قرار بقانون»، وهي تشريعات كان ينبغي أن تناقش في مجلس تشريعي منتخب وممثل للناس. لكن غياب المجلس التشريعي منذ الانقسام عام 2007، وغياب الإرادة السياسية لإجراء انتخابات حقيقية، سمح للرئيس بأن يمارس سلطة شبه مطلقة في المجال التشريعي. ومع مرور السنوات، تحولت هذه القرارات إلى روتين سياسي وإداري، تُدار به شؤون السلطة، دون رقابة، ودون مشاركة مجتمعية، ودون حوار، ودون أي اعتبار لمفهوم الفصل بين السلطات الذي يُفترض أن يشكل أساس الحكم الرشيد.
وفي هذا السياق، يبدو قرار تعيين نائب للرئيس واحداً من أبرز مؤشرات انهيار فكرة «الإصلاح» من أساسها. فالتعيين لم يكن استحقاقاً دستورياً ولا ضرورة نابعة من نظام سياسي يعمل وفق قواعد واضحة، بل أتى استجابة لضغوط عربية وأجنبية أرادت ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني تحسباً لأي فراغ في القيادة، أو لضمان انتقال سلس للسلطة ضمن شبكة المصالح نفسها التي تدير المشهد منذ سنوات. بهذا المعنى، لم يكن تعيين نائب للرئيس خطوة إصلاحية، بل خطوة تعمّق الأزمة، لأنها تُدار خارج مؤسسات السلطة، وتتم وفق حسابات خارجية، وتتنافى مع أبسط المعايير الديمقراطية التي تُفترض عند شغل منصب بهذا الحجم.
وإلى جانب ذلك كله، يظل غياب الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأكثر من خمسة عشر عاماً جرحاً مفتوحاً في الحياة السياسية الفلسطينية. هذه الفترة ليست مجرد رقم، بل زمن طويل تراكمت خلاله سلطات مطلقة، وتآكلت قواعد المشاركة، وفقد الجمهور ثقته تدريجياً في أي وعود تتحدث عن تجديد الشرعية. أكثر من جيل كامل لم يختبر صندوق الاقتراع، ولم يسهم فعلياً في اختيار قيادته، ولا في رسم السياسات العامة التي تؤثر في مصيره. ومع ذلك، تستمر السلطة في إدارة الشأن العام بذات الآليات، وتستمر الدول الداعمة لها في مكافأتها سياسياً ومالياً، طالما بقيت متوافقة مع مصالحها الأمنية والسياسية.
إن «أسطورة الإصلاح» كما تظهر اليوم ليست سوى إعادة إنتاج لخطاب يريد الإيحاء بأن السلطة تتغير وتتطور وتستجيب للضغوط، بينما الحقيقة هي أنها تخضع فقط للضغوط الخارجية، وتتجاهل تماماً مطالب مجتمعها، وتعمل على حماية بنية حكم تتركز فيها السلطات، وتتجنب المساءلة، وتبقي ملفات الفساد دون معالجة حقيقية، وتقدم تنازلات شكلية بدلاً من تغييرات جذرية. من دون انتخابات، ومن دون إصلاح قضائي مستقل، ومن دون فصل فعلي للسلطات، ومن دون شفافية مالية وإدارية، ومن دون مشاركة مجتمعية في صياغة الأولويات الوطنية، لا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن يكون ذا معنى.
المفارقة أن المجتمع الفلسطيني، رغم جميع الصعوبات والانقسامات، يظل أكثر تقدماً من قيادته في فهم معنى الإصلاح. فالنقاشات اليومية، والحراك الشبابي، والضغط المتزايد من مؤسسات المجتمع المدني، كلها تشير إلى أن الفلسطينيين يريدون نظاماً سياسياً يعبر عنهم، ويخضع للمحاسبة، ويستند إلى شرعية ديمقراطية حقيقية، لا إلى شرعية الأمر الواقع أو شرعية الاعتراف الخارجي. لكن طالما بقيت علاقة السلطة بالممولين الغربيين هي المحدد الأول لتوجهاتها، وطالما بقيت الأولوية هي الحفاظ على الدعم المالي والتنسيق الأمني، ستبقى أسطورة الإصلاح مجرد قشرة تجميلية تحاول تغطية واقع سياسي مترهل.
وفي وقت سياسي معقد تتم فيه الترتيبات لما ستكون عليه اوضاع غزة من كافة الجوانب بعد الحرب من قبل قوى دولية واقليمية، وتتصاعد فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية، تبدو الحاجة إلى إصلاح حقيقي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تستطيع سلطة نشأت وتطورت في بيئة محكومة باتفاقات ادارت إسرائيل ظهرها لها، والمصالح الخارجية، وغياب السيادة الفعلية، أن تنتج إصلاحاً حقيقياً؟ الإجابة حتى الآن لا توحي بذلك. ما يجري اليوم ليس إصلاحاً، بل إدارة للأزمة، ومناورة سياسية، ومحاولة لإعادة إنتاج السلطة نفسها بصيغ جديدة لكنها بمضمون قديم، بينما يبقى الشعب الفلسطيني خارج إطار القرار، ينتظر يوماً تتحقق فيه إرادته لا إرادة الممولين.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96908