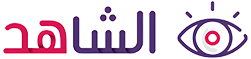السلطة في مهب التحولات: هل من خلاص لمرحلة ما بعد أوسلو؟

رام الله – الشاهد| كتبت دينا أبو دية.. مثّلت عملية “طوفان الأقصى” وما أعقبها من عدوان إسرائيلي على غزة نقطة تحول مفصلية في مسار القضية الفلسطينية برمتها، والسلطة الفلسطينية تحديدا. لم تكن هذه الأحداث مجرد تصعيد عسكري عابر، بل تجسيد صارخ لانهيار نموذج “ما بعد أوسلو” الذي حكم المشهد لعقود، وكشفت عن تحديات هيكلية عميقة.
في خضم هذا الواقع المضطرب، تبرز تعقيدات المشهد من منظور السلطة ذاتها، والتي ترى في الحفاظ على استقرار الضفة الغربية أولوية قصوى، خشيةً من أن يؤدي أي تصعيد واسع النطاق إلى تكرار سيناريو غزة الكارثي، بما يحمله من دمار هائل وتداعيات إنسانية واقتصادية لا تُحمد عقباها. هذا التخوف، وإن كان يضعها في موقع حرج أمام تطلعات الشارع، إلا أنه يمثل دافعاً أساسياً لسياساتها في إدارة الأزمات، وإن كانت تعمل تحت ضغوط دولية وإسرائيلية هائلة تُقيد خياراتها وتزيد من تعقيد مهمتها. هذا الواقع الجديد يتطلب قراءة متعمقة تتجاوز السرد الوصفي لتلامس جوهر التحديات الهيكلية التي تعصف بالسلطة ومستقبلها. إن السلطة اليوم ليست مجرد كيان يرزح تحت الضغوط، بل هي في مفترق طرق تاريخي يفرض عليها خياراً وجودياً: إما إعادة ابتكار ذاتها أو مواجهة الفلاش الوجودي.
1. شرعية قيد التساؤل: مسافة بين الكيان وتطلعات الشعب
كشفت الأحداث الأخيرة، وخاصة “طوفان الأقصى”، عن تحديات عميقة تواجه شرعية السلطة الفلسطينية، وهي تحديات تراكمت على مدى عقود وشهدت تزايداً في ظل غياب التجديد الديمقراطي. لم يعد الأمر مقتصراً على غياب التمثيل الديمقراطي فحسب، بل يتعداه إلى تساؤلات حول الشرعية الوطنية والأخلاقية التي تستمد منها أي قيادة قوامها.
“البروتوكول” في مواجهة “المقاومة”: تباين في الأدوار
بينما انخرط الشارع الفلسطيني في دعم المقاومة، وشهد صموداً استثنائياً في غزة، بقيت السلطة ملتزمة بقيود “التنسيق الأمني” الذي يحد من حركتها في سياقات معينة، هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى قدرة السلطة على التماهي الكامل مع نبض الشارع في لحظات التصعيد، مما قد يؤدي إلى شعور بوجود فجوة بين نهج السلطة وتطلعات الشارع الفلسطيني؛ فقد أظهرت العديد من الاستطلاعات أن أغلبية فلسطينية واسعة تعارض استمرار هذا التنسيق الأمني، مما يعكس تآكلاً كبيرًا في شرعية السلطة لدى الشارع. كيف يمكن لكيان يدعي تمثيل الشعب أن يظل ملتزماً بمسارات معينة بينما يتعرض جزء من أبنائه لضغوط مكثفة؟ في أوج العدوان على غزة، كانت صور المقاومين تتصدر المشهد في الشوارع الفلسطينية والعربية، بينما تعرضت بعض جوانب أداء السلطة للنقد جراء استمرار هذا التنسيق. هذا التباين، وإن كان يضع السلطة في موقع حرج، إلا أنه أيضاً يعكس إرثاً هيكلياً من اتفاقيات تفرض عليها قيوداً لا يمكن تجاهلها، مما يُنشئ فجوة بين الواقع السياسي المفروض وتطلعات الشارع الثوري.
“الخلاص الاقتصادي” رهان يواجه صعوبات:
راهنت السلطة لعقود على أن التنمية الاقتصادية المحدودة يمكن أن توفر بديلاً عن غياب الأفق السياسي الواضح. لكن الأحداث أثبتت أن هذا الرهان يواجه تحديات جمة؛ فإجراءات الاحتلال تفرض قيوداً كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، وقد تُستخدم كأداة للضغط والتحكم وليس لدعم التحرر. حتى أموال المقاصة، التي تُحتجز بانتظام، ليست مجرد معضلة مالية، بل هي رمز للهشاشة والتبعية، وقد تؤثر على استقلالية السلطة في نظر الشارع. شهدنا استمرار سياسة الاحتلال في اقتطاع أموال المقاصة، وهذا يطرح تساؤلات حول قدرة السلطة على اتخاذ خطوات سيادية حاسمة لوقف هذا الابتزاز. هذا الرهان لم يواجه قيود الاحتلال فحسب، بل أدى أيضاً إلى تآكل تدريجي في القدرة الإنتاجية الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، مما جعله يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية وأموال المقاصة، وبالتالي أصبح أقل قدرة على استيعاب تطلعات الشباب المتزايدة وخلق فرص عمل حقيقية.
قيادة بين التحديات والشارع:
لا يقتصر الأمر على غياب الانتخابات، بل يتعداه إلى شعور بوجود مسافة بين القيادة وهموم الشارع الفلسطيني وطموحاته. فالإحصائيات المستمرة تُظهر تراجعًا كبيرًا في شعبية وشرعية السلطة الفلسطينية، مدفوعًا بغياب التجديد الديمقراطي والفساد المتصور. هذا الانفصال، الذي قد يكون تعمق بفعل الأحداث الأخيرة، يجعل أي محاولة لإعادة بناء الشرعية من الداخل أمراً يواجه تحديات كبيرة في ظل التوجهات الراهنة. لم يعد جزء من الشارع يرى في السلطة تجسيداً كاملاً لطموحاته الوطنية، بل مجرد امتداد لوضع قائم يواجه انتقادات. والاحتجاجات الشعبية المتكررة في الضفة الغربية، التي قوبلت أحياناً بإجراءات أمنية، كانت تعبيراً عن تساؤلات متصاعدة حول أداء السلطة، مما يشير إلى الحاجة لمعالجة هذه المسافة.
2. تشابك إقليمي: أفول مركزية القضية الفلسطينية
لم يعد الدعم العربي للقضية الفلسطينية مطلقاً أو غير مشروط كما كان في السابق؛ فالمشهد الإقليمي اليوم يتسم بديناميكيات معقدة وتوازنات متغيرة تقلص من أهمية السلطة ودورها المركزي:
التطبيع في “غيبوبة تكتيكية”:
رغم تجميد مسار التطبيع الرسمي مع إسرائيل بفعل ضغط الشارع العربي، فإن هذا التجميد يبدو تكتيكياً محضاً لا استراتيجياً. فالدول الإقليمية التي سعت للتطبيع لم تتخلَّ عن أهدافها بعيدة المدى، وقد تعيد إحياء هذا المسار فور خفوت زخم الحرب، وربما بوجود “غطاء” فلسطيني شكلي. فهل ستُستخدم السلطة كـ”ورقة توت” لتغطية عودة التطبيع؟ فبالرغم من الإدانة العربية الواسعة للعدوان على غزة، إلا أن الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل لم تسحب سفراءها بشكل دائم أو تلغِ اتفاقياتها القائمة بصفة نهائية، مما يشير إلى أن التجميد قد يكون مجرد استراحة محارب مؤقتة.
صعود محاور جديدة وتراجع نفوذ السلطة:
أظهرت الحرب تنامي نفوذ محاور إقليمية تتحدى الهيمنة التقليدية وتوظف أوراقاً عسكرية أو سياسية مغايرة. هذه المحاور، مثل محور المقاومة الإقليمي الذي يضم فصائل مختلفة وبعض الدول الفاعلة (كإيران وحلفائها)، باتت فاعلاً رئيسياً على الساحة، وذات تأثير مباشر على مسار الصراع. الدعم العسكري والسياسي الذي قدمته بعض هذه المحاور لفصائل المقاومة في غزة، بالتوازي مع جهود إغاثية غير مباشرة، جسّد تهميشاً لدور السلطة كفاعل إقليمي محوري في إدارة الصراع. هذا لا يعني بالضرورة زوال السلطة، بل يعني أنها باتت مجرد طرف ثانوي في معادلات إقليمية أكبر، تُدار بعيداً عن كواليسها، مما يقلص من هامش حركتها الدبلوماسية والسياسية.
تغير أولويات المانحين:
أدت الحرب إلى إعادة تقييم بعض المانحين الإقليميين لدعمهم، وقد يُعاد توجيه هذا الدعم نحو قنوات مختلفة (مثل الإغاثة الإنسانية، أو دعم فصائل معينة) مما يقلل من نفوذ السلطة ويزيد من تبعيتها لمن يدعمها. لوحظ أن جزءاً من جهود الإغاثة الإنسانية، خاصة لغزة، باتت تتم عبر منظمات دولية أو حتى قنوات غير رسمية، بدلاً من التنسيق الكامل والمباشر مع السلطة الفلسطينية، في إشارة إلى تحول في آليات الدعم.
3. ازدواجية دولية: “حل الدولتين” قناع للاحتلال
تعاني السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية من ازدواجية صارخة تفاقمت مع الحرب، حيث يتناقض الخطاب المعلن مع الممارسات على الأرض بشكل فاضح:
“حل الدولتين” كـ”طعم” سياسي:
عادت الكثير من الدول الغربية لتلوح بـ”حل الدولتين” كحل سحري بعد الحرب. لكن التحليل النقدي يكشف أن هذا الخطاب غالباً ما يكون مجرد قناع لتبرير استمرار الاحتلال وإفراغ المفهوم من مضمونه السيادي. فهم لا يتحدثون عن دولة فلسطينية حقيقية قابلة للحياة، بل عن كيان منزوع السيادة، مجزأ جغرافياً، ومقيّد أمنياً. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن تأييد حل الدولتين بين الفلسطينيين كان في انخفاض مستمر قبل “طوفان الأقصى”، حيث وصل إلى 24% فقط في أوائل عام 2023. هذا الانخفاض يعكس إدراكًا شعبيًا متزايدًا بأن هذا الحل، كما يُطرح دوليًا، لا يلبي الحد الأدنى من التطلعات الفلسطينية. عندما تتحدث الولايات المتحدة عن “حل الدولتين” وتدعو لإقامته، فإنها في الوقت ذاته تواصل تدفق شحنات الأسلحة المتطورة لإسرائيل، وتستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد أي قرار يدين الاستيطان أو يطالب بوقف العدوان، مما يعري التناقض بين الخطاب والممارسة الفعلية على الأرض.
توظيف السلطة في “سيناريوهات ما بعد الحرب”:
لا يُنظر إلى السلطة من قبل القوى الدولية الفاعلة كشريك متساوٍ، بل كـ**”أداة وظيفية”** لإدارة غزة في “اليوم التالي” أو لضمان الأمن الإسرائيلي. هذا التوظيف يُفرغ السلطة من أي بعد وطني أو تحرري، ويضعها في موقف حرج أمام شعبها الذي يرفض أن تكون مجرد وكيل للاحتلال أو لجهاز إغاثي. المقترحات الأمريكية والأوروبية المتكررة حول “إعادة تأهيل” السلطة لتولي إدارة غزة ما بعد الحرب، دون أي حديث جدي عن إنهاء الاحتلال أو استعادة السيادة الفلسطينية الكاملة، يوضح بجلاء كيف تُصنّف السلطة كجهة إدارية لا كممثل شرعي لدولة ذات سيادة.
تغير موازين القوى العالمية وأثره المحدود:
على الرغم من صعود قوى مثل الصين وروسيا في الساحة الدولية، فإن تأثيرها المباشر على واقع السلطة لا يزال محدوداً. فالتحدي الأكبر يكمن في قدرة هذه القوى على ترجمة خطابها الداعم للقضية الفلسطينية إلى ضغط فعال على إسرائيل والولايات المتحدة لتغيير الواقع على الأرض. وبالرغم من الإدانة الصينية والروسية المتكررة للعدوان الإسرائيلي ودعوتهما لوقف إطلاق النار، فإن نفوذهما لم يترجم بعد إلى تغيير جوهري في سياسات الاحتلال أو في الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل، مما يترك السلطة حبيسة وضع صعب بين خطاب داعم بلا تأثير عملي وواقع مرير لا يتغير.
4. التحديات الداخلية والمعيقات الذاتية: البنية المؤسسية والفصائلية
بالإضافة إلى العوامل الخارجية والإقليمية، تواجه السلطة الفلسطينية تحديات جوهرية من داخل بنيتها، تساهم في إضعافها وتآكل شرعيتها:
الانقسام الفلسطيني كمرض مزمن ومسؤولية مشتركة:
لم تنجح السلطة في رأب الصدع بين فصائل المقاومة، خاصة الانقسام بين حركتي فتح وحماس. هذا الانقسام لا يضعف الموقف الفلسطيني الموحد فحسب، بل يمنح الاحتلال ذريعة مستمرة لتقسيم الشعب الفلسطيني وإدارة الصراع بدلاً من حله. لقد أظهرت الحرب الأخيرة في غزة الحاجة الملحة للوحدة الوطنية، ومع ذلك، بقيت محاولات المصالحة تراوح مكانها، مما يعكس عمق التحدي الذاتي. لا يقتصر هذا الانقسام على إضعاف الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، بل خلق أيضاً ازدواجية في البنى الإدارية والخدمات، وأرهق المجتمع الفلسطيني. إن تحمل مسؤولية هذا الانقسام لا يقع على عاتق السلطة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة تتحملها كافة الفصائل والأطراف الفلسطينية الرئيسية التي لم تتمكن من تجاوز مصالحها الضيقة وإيجاد صيغة حقيقية للوحدة، مما جعل استعادة هذه الوحدة مهمة عسيرة في ظل غياب إرادة سياسية جامعة.
البيروقراطية والتضخم المؤسسي:
تعاني السلطة من بيروقراطية متضخمة ومؤسسات غير فعالة في كثير من الأحيان، مما يعيق قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات الشعب. هذا التضخم الوظيفي يُنظر إليه من قبل الكثيرين على أنه استنزاف للموارد وتكريس لثقافة الامتيازات بدلاً من الخدمة العامة.
غياب استراتيجية وطنية موحدة:
تفتقر القيادة الفلسطينية، بما فيها السلطة، إلى استراتيجية وطنية واضحة وموحدة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. فبينما يرى البعض في المقاومة المسلحة خياراً وحيداً، يرى آخرون في العمل الدبلوماسي والمفاوضات الطريق الأمثل. هذا التشتت في الرؤى يضعف القدرة الفلسطينية على فرض أجندتها على الساحة الدولية.
فساد مستشرٍ وتوزيع للمصالح:
تعد اتهامات الفساد، الحقيقية والمدركة، من أهم العوامل التي أدت إلى تآكل ثقة الشارع بالسلطة. فقد أظهرت استطلاعات الرأي، مثل استطلاع عام 2021، أن 63% من الفلسطينيين يرون أن مستوى انتشار الفساد في مؤسسات السلطة كبير وقد ازداد. عندما يُنظر إلى القيادة على أنها منخرطة في قضايا فساد أو أنها تخدم مصالح ضيقة، فإن شرعيتها الأخلاقية تتلاشى بشكل سريع. هذه النقطة بالتحديد هي إحدى الركائز الأساسية التي يبنى عليها رفض الشارع لأي قيادة لا تخضع للمساءلة.
5. دور الشباب الفلسطيني والمجتمع المدني: محركات التغيير الصامتة
على الرغم من اليأس السائد، يمثل الشباب الفلسطيني والمؤسسات المدنية حراكاً صامتاً، لكنه قوي، يمكن أن يكون بذرة التغيير المستقبلي:
جيل جديد يرفض الواقع:
يمثل الشباب الفلسطيني، خاصة جيل ما بعد أوسلو، قوة دافعة للتغيير. لم يعش هذا الجيل وهم السلام الذي روّجت له اتفاقيات أوسلو، بل نشأ في ظل استمرار الاحتلال وتوسع الاستيطان. لديهم رؤية أكثر جذرية للمقاومة والتحرر، وهم أقل ارتباطاً بالبنى السياسية التقليدية، مما يجعلهم أكثر استعداداً للمطالبة بالتغيير الجذري. كثيرًا ما يُظهر الشباب الفلسطيني ميلًا أكبر لمعارضة حل الدولتين، ليس لأسباب أيديولوجية بالضرورة، بل لاعتقادهم بعدم قابليته للتطبيق ولتطلعاتهم نحو دولة ديمقراطية خالية من الفساد.
حراك المجتمع المدني والعمل القاعدي:
على الرغم من القيود، لا تزال مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء القاعديون يلعبون دوراً حيوياً في توثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم الإنساني، وتنظيم الفعاليات الاحتجاجية السلمية، وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية دولياً. هذا الحراك، وإن كان لا يمتلك قوة السلطة الرسمية، إلا أنه يمثل نبض الشارع الفلسطيني وصوته الذي لا يُخمد، ويمكن أن يشكل نواة لشرعية بديلة.
التأثير الرقمي و”مقاومة الرواية”:
يلعب الشباب الفلسطيني دوراً رائداً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنقل رواية الصراع، وفضح جرائم الاحتلال، والتعبئة الشعبية. هذه “المقاومة الرقمية” تتجاوز القيود الجغرافية والسياسية، وتصل إلى جمهور عالمي، مما يعزز التضامن مع القضية ويضغط على الرواية الإسرائيلية الرسمية.
6. سيناريوهات المصير: هل تولد قيادة جديدة من رماد الحرب؟
في خضم هذا المشهد المعقد والضبابي، لم يعد أمام السلطة الفلسطينية ترف الاستمرار على ذات الوتيرة. السيناريوهات المحتملة لمستقبلها تُشير إلى تحول جذري لا مفر منه:
سيناريو “الاحتضار التدريجي والتحول الوظيفي”:
تستمر السلطة في شكلها الحالي، لكنها تفقد ما تبقى من نفوذ وشرعية، وتتحول فعلياً إلى كيان إداري محدود الصلاحيات يعمل تحت مظلة الاحتلال وبتمويل دولي مشروط. هذا يعني دفن أي طموح لدولة ذات سيادة حقيقية.
سيناريو “إعادة التشكيل القسري من الخارج”:
قد تفرض قوى دولية وإقليمية، بالتنسيق مع إسرائيل، هيكلة جديدة للسلطة، ربما بوجوه جديدة، ولكن بنفس الصلاحيات المحدودة، لخدمة أجندة “الاستقرار” التي تعني استمرار الاحتلال بطريقة معدلة.
سيناريو “انبعاث القيادة من رحم الشعب والمقاومة”:
قد يؤدي الفراغ السياسي وتراكم الإحباط إلى ظهور قيادة فلسطينية جديدة من رحم الشعب، سواء من خلال الحراك الشبابي، أو الفصائل الميدانية، أو حتى شخصيات وطنية مستقلة تكتسب شرعيتها من الميدان ومن التصدي للاحتلال. هذه القيادة قد تنبع من زخم المقاومة في غزة والضفة، أو من الحراكات الشبابية التي ترفض الوضع الراهن وتطالب بالتغيير الجذري، أو من قوى سياسية داخلية لم تنخرط في مسار أوسلو البائد. تحقيق هذا السيناريو لا يتطلب فقط تفكيكاً حقيقياً لبنية السلطة الحالية، بل إعادة بناء المشروع الوطني من جديد على أسس المقاومة الشاملة بكافة أشكالها، والوحدة الداخلية الحقيقية، وتفعيل دور المؤسسات الشعبية والديمقراطية الأصيلة. إنها عملية بناء صعبة تتطلب تضحيات جسام، وتخلياً عن أنماط التفكير القديمة، وإعادة تعريف لمفهوم القيادة والتمثيل.
البحث عن بوصلة في عالم مضطرب
إن “طوفان الأقصى” لم يكشف فقط عن وحشية الاحتلال، بل أزاح الستار عن هشاشة النموذج السياسي الفلسطيني الحالي الذي تمثله السلطة. لم يعد السؤال ما إذا كانت السلطة ستصمد، بل أي سلطة ستصمد، وبأي شكل، ولأي غاية؟ إن اللحظة التاريخية الراهنة تفرض على الفلسطينيين قاطبة، وعلى قياداتهم، أن يعيدوا التفكير جذرياً في استراتيجيتهم، وأن يبحثوا عن بوصلة جديدة تقودهم نحو التحرر والسيادة، بدلاً من التيه في متاهات تسويات أثبتت فشلها الذريع. فهل تمتلك النخب الفلسطينية الشجاعة لتغيير المسار، أم أنها ستظل متمسكة بخيوط شبكة عنكبوتية أصبحت عاجزة عن حماية أي شيء؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي ستُجيب عنه الأيام القادمة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91176