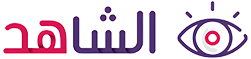انتخابات المجلس الوطني المنتظرة: بين الاقصاء والإجماع
آخر تحديث :

رام الله – الشاهد| خط الكاتب طاهر المصري مقالاً حول الدعوات الإقصائية من قبل زعيم حركة فتح محمود عباس بشأن المشاركة في أي انتخابات فلسطينية مقبلة، واشتراط عباس وسطلته وحركته على من يريد المشاركة الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها الاعتراف بـ”إسرائيل” وفيما يلي نص المقال.
بعيداً عن التشكيك والتخوين، فإن هذا المقال يهدف إلى إثارة نقاش حول الجدوى من الدعوة إلى انتخابات المجلس الوطني في هذا التوقيت، وحول الكيفية التي يمكن من خلالها تحويل هذه الدعوة إلى فرصة حقيقية لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس تشاركية، تكفل تمثيل جميع مكونات الشعب الفلسطيني وتستعيد روح الإجماع لا الإقصاء.
بينما يواجه الشعب الفلسطيني إحدى أكثر لحظاته التاريخية قسوةً وخطورة تحت نيران الإبادة الجماعية والتهجير القسري والفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومع تفاقم الانقسام الداخلي، والتوجه نحو الخلاص الفردي وضياع ثقافة المصير الوطني المشترك، برزت الدعوة لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، مشروطة بالالتزام المسبق بـ”البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية”.
قد تبدو هذه الدعوة، في ظاهرها، خطوة نحو تفعيل المؤسسة التمثيلية الأعلى للشعب الفلسطيني، إلا أن مضمونها يطرح تساؤلات جوهرية حول المشروعية والمضمون، ويعيد فتح النقاش حول تعريف “من هو الفلسطيني الذي يستحق التمثيل”؟.
وفي خضم الحديث عن انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، عاد إلى الواجهة نقاش خطير حول شروط الترشح والمشاركة، يتلخص في اشتراط الالتزام بما يُسمى “البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية”، كشرط مسبق لقبول أي دور في مؤسساتها. ورغم ما قد يبدو عليه هذا الشرط من منطق تنظيمي، إلا أنه ينطوي على ما هو أخطر من ذلك بكثير: محاولة لتقييد الحق السياسي والتمثيل الوطني بمواقف أيديولوجية وسياسية محددة، وإعادة
تعريف الهوية الوطنية الفلسطينية على أساس الولاء السياسي، لا على قاعدة الانتماء الجمعي والحقوق غير القابلة للتصرف.
ما يُطرح اليوم لا يمكن فصله عن سياق أوسع من محاولات تطويع النظام السياسي الفلسطيني ليتلاءم مع شروط مرحلة ما بعد أوسلو، وهي مرحلة تعثرت منذ ولادتها، وفشلت في إنجاز أي من الوعود التي بُنيت عليها. والأخطر أن يُعاد الآن تقديم هذه المرحلة باعتبارها الأساس الوحيد للشرعية السياسية، ويُفرض على الفلسطينيين الاعتراف بها كمدخل للمشاركة، رغم أن التجربة أثبتت أنها لم تكن سوى أداة لتقليص المشروع الوطني، وتحويله
من حركة تحرر إلى سلطة إدارية محدودة الصلاحيات، محاصرة بالقيود الإسرائيلية والتمويل المشروط.
هذا الإصرار على اشتراط الاعتراف بأوسلو وبرنامج المنظمة –بصيغته الحالية– يمثل قطيعة خطيرة مع الركائز التأسيسية للشرعية الفلسطينية. فـوثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني في دورته التاسعة عشرة عام 1988، والتي تُعد الوثيقة المرجعية المؤسسة لدولة فلسطين، لم تُشر إطلاقاً إلى التزامات سياسية مسبقة من هذا النوع، بل ارتكزت على منظومة من القيم والمبادئ العالمية، وعلى رأسها العدالة، والكرامة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أكدت على استناد فلسطين إلى قرارات الشرعية الدولية، لا إلى تسويات جزئية مؤقتة.
وقد نصت الوثيقة بوضوح على أن دولة فلسطين تقوم على “أسس الحرية والعدل والمساواة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الطابع الديمقراطي البرلماني” الذي يضمن التعددية السياسية. وهذا يعكس بجلاء أن الأساس الذي قامت عليه الفكرة الدستورية الفلسطينية، لم يكن قائماً على برنامج سياسي بعينه، بل على مبدأ الشراكة والتعدد.
والأهم أن الوثيقة، ومن خلفها المجلس الوطني في تلك الدورة، لم تكن تخاطب فئة دون أخرى، بل خاطبت كل الفلسطينيين، في الداخل والشتات، وأعادت التأكيد على عضويتهم الطبيعية في منظمة التحرير الفلسطينية، التي شُكّلت أصلاً لتجسيد وحدتهم الوطنية، لا لفرض وصايات سياسية عليهم. وهذا ما يجعل من محاولة حصر التمثيل الفلسطيني، أو تقييده بشرط سياسي مسبق، فعلاً مضاداً لروح وثيقة الاستقلال، وعدواناً على مضمونها.
في ظل هذا المشهد، تصبح الانتخابات المزمع عقدها مدخلاً خطيراً نحو تأسيس نظام سياسي جديد، يقوم لا على التوافق الوطني أو الشرعية الشعبية، بل على ترسيخ طابع استبعادي، يُقصي من لا يعترف بالاتفاقات التي جرّدت المشروع الفلسطيني من جوهره التحرري. وإذا كان هذا يحدث تحت شعار “استعادة المؤسسات”، فإن الحقيقة أن هذه الاستعادة تتم بشروط الإقصاء، لا بشروط المشاركة.
ولعل الأكثر مدعاة للقلق أن هذا التوجه يتم ترويجه وكأنه ضرورة لحماية “الشرعية”، في حين أن المفهوم ذاته يتعرض للنسف من الداخل. إذ كيف يمكن اعتبار منظمة التحرير ممثلة شرعية ووحيدة للشعب الفلسطيني، إذا كانت تغلق أبوابها أمام من يختلفون مع برنامجها السياسي؟ إن الشرعية، في السياق الفلسطيني، لم تكن يوماً شرعية سلطة، بل شرعية تمثيل جامع، يستوعب التعدد السياسي والفكري، لا يضيق به.
في هذا الإطار، يُصبح من المشروع التساؤل: من يملك الحق في إعادة تعريف الوطنية الفلسطينية؟ هل هو الشخص الذي يملك مفاتيح القرار السياسي، أم الشعب الذي لا يزال يدفع أثمان الاحتلال والشتات والخذلان؟ ومن يقرر من هو الوطني ومن هو الخارج على الإجماع؟ هل هو من أدار ظهره لمقومات الصمود؟، أم من لا يزال يتمسك بحقه في الدفاع عن أرضه وكرامته بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها القانون الدولي؟
ولأن ما يُطرح اليوم لا يتعلق بمجرد إجراء انتخابي، بل بمستقبل الكيان السياسي الفلسطيني، فإن مسؤولية النخب السياسية –وخاصة قوى اليسار والتقدميين– تصبح أكبر من مجرد تسجيل مواقف. فهذه القوى، التي طالما رفعت شعارات العدالة والمساواة والتمثيل الديمقراطي، تجد نفسها أمام اختبار تاريخي لا يتعلق بمبادئ مجردة، بل بمصير وطن برمته. فالصمت، أو القبول الضمني بشروط إقصائية كهذه، لا يعني فقط المساهمة في تمرير مشروع يفتقر إلى الحد الأدنى من الإجماع، بل يعني الانخراط في تأسيس نظام سياسي استبدادي المقاصد، نخبوي التمثيل، وأمني الطابع.
إن قوى اليسار مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالوقوف في وجه هذه الدعوات السياسية التي تُلبس نفسها لباس “الشرعية”، وهي الفاقدة حُكماً لها. وإن الدفاع عن وثيقة إعلان الاستقلال، باعتبارها العقد السياسي الأعلى الذي ينظم العلاقة بين الفلسطينيين، يقتضي الوقوف ضد كل ما يناقض مبادئها، وعلى رأسه هذا المسعى لاختزال الوطنية في بنود اتفاق لم يعد يملك أي مشروعية سياسية أو أخلاقية.
إن الانتخابات ليست هدفاً في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الشراكة والتمثيل. وحين تتحول إلى أداة لفرض الطاعة، وإقصاء المختلفين، فإنها تصبح خطراً على القضية نفسها، لا سبيلاً لحمايتها.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92028