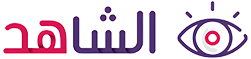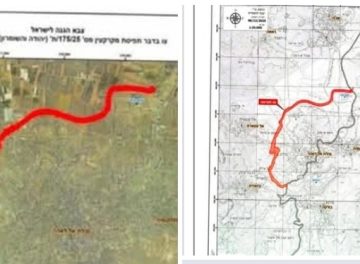المراسيم تمشي وحدها… والشعب لا يعرف من يحكمه

رام الله – الشاهد| كتب غسان جابر: في بلادٍ تتكاثر فيها القرارات كالفصول، يخرج مرسومٌ جديد كل بضعة أشهر، يغيّر ترتيب الكراسي، ويبدّل ألوان الستائر في المقاطعة.
أما الناس، فقد تراجع اهتمامهم من “من يحكم؟” إلى “كم بقي من الراتب؟”.
لم يعد أحد يحفظ أسماء الوزراء، وربما يأتي يومٌ — إذا استمرت الأمور بهذا الإيقاع — لا يعرف الشعب اسم رئيسه أيضًا، ويكتفي بأن يقول: “اللي فوق، الله يطوّل بعمره”.
في العامين الأخيرين، صدرت مراسيم دستورية متلاحقة جعلت المواطن الفلسطيني يشعر وكأنه يشاهد حلقةً طويلة من مسلسلٍ بلا عنوان.
مرسوم يعيّن رئيس المجلس الوطني مؤقتًا، وآخر يلغيه، وثالث يضع نائب رئيس اللجنة التنفيذية في المقعد ذاته.
كأننا أمام لعبة كراسي موسيقية لا أحد يعرف متى تتوقف الموسيقى ولا من سيجلس في النهاية.
المرسوم الأول عام 2024 كان أقرب للمنطق القانوني: رئيس المجلس الوطني يتولى الرئاسة مؤقتًا عند شغور المنصب، إلى حين إجراء انتخابات خلال 90 يومًا.
هذا يتسق مع روح النظام الأساسي الفلسطيني الذي يربط مؤسسات السلطة بمنظمة التحرير، المرجعية الأم لكل الشرعيات.
لكن في أكتوبر 2025، صدر مرسوم جديد ألغى المرسوم السابق، وأسند المهمة إلى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس دولة فلسطين، وهو منصب لم يكن له وجود قانوني من قبل.
وبهذا، تحول النص من اجتهادٍ دستوري إلى تفصيلٍ سياسي على مقاس الأشخاص.
القانون يقول شيئًا، والواقع يقول: “الأهم من النص هو من يقرأ النص”.
من الناحية القانونية، المادة (37) من النظام الأساسي واضحة:
إذا شغر منصب الرئيس، يتولى رئيس المجلس التشريعي مهامه لمدة لا تتجاوز 90 يومًا تُجرى خلالها انتخابات.
لكن بما أن المجلس التشريعي تم حله منذ عام 2018، تعطّلت هذه المادة عمليًا.
البدائل التي لجأ إليها الرئيس — كإسناد المهام لرئيس المجلس الوطني أو لاحقًا لنائب رئيس اللجنة التنفيذية — لا تستند إلى نص، بل إلى “ضرورة سياسية” تبرر الخروج عن النص.
وهكذا، تحوّل الاستثناء إلى قاعدة، والضرورة إلى سياسة، والسياسة إلى دستور جديد يُكتب على الورق الأبيض كل عام.
في المقابل، الفصائل — التي يفترض أن تكون رقيبًا على الدستور والشرعية — تلتزم صمتًا يشبه صمت المقابر.
الأمناء العامون مشغولون بحوار “الوحدة” الذي لا يتحد، وبلقاءات “المصالحة” التي لا تصالح.
كلٌّ منهم ينتظر دوره في النعي السياسي القادم، أو مقعده في لجنةٍ لا تجتمع، أو منحةٍ لا تصل.
حتى بياناتهم باتت تُكتب بنظام النسخ واللصق: نرفض العدوان، نستنكر الانقسام، ونثمّن جهود القيادة الحكيمة.
وحين صدر المرسوم الأخير، لم يصدر عن أي فصيل تعليقٌ جاد أو موقف واضح.
ربما لأن الجميع ينتظر دوره في “التعيين القادم”، أو لأن السكوت صار وسيلة لتجنب الغضب والحرمان من المنصب.
كأنّ الصمت أصبح الفصيل الوحيد المتفق عليه في الساحة الفلسطينية.
الشعب من جانبه يكتفي بالتعليقات الساخرة:
> “همّهم مين يخلف الرئيس، وإحنا مش لاقيين مين يخلّصنا من الكهرباء”.
“يغيّروا المراسيم قد ما بدهم، إحنا بنغيّر القناة”.
هكذا تحوّل المواطن إلى مراقبٍ ساخرٍ من خلف الشاشة، يتفرّج على دولةٍ تدور في حلقة دستورية مغلقة، لا تعرف من أين تبدأ ولا إلى أين تنتهي.
في العمق، ما يجري ليس صراعًا على السلطة فقط، بل صراع على من يملك شرعية القرار القادم.
كل مرسوم جديد ليس مجرد توقيعٍ بالحبر، بل إعادة توزيعٍ للصلاحيات والولاءات، بين من يريد السلطة، ومن يريد أن يورّثها، ومن يريد أن ينجو من تبعاتها.
أما الدستور الفلسطيني، فقد تحول من “القانون الأعلى” إلى “النص المؤجل”، يُستحضر فقط عندما يكون في خدمة الواقع، ويُنسى حين يصطدم بالمصالح.
ورغم كل ذلك، تبقى فلسطين هي الخاسر الأكبر من هذه المراسيم المتناقضة.
فبين مرسوم يعيّن وآخر يُلغي، تتآكل فكرة الدولة ذاتها.
نحن ننتقل من “سلطة بلا دولة” إلى “قرارات بلا سلطة”.
لكن، لعلّ أجمل ما في المشهد هو سخرية القدر:
فحين يُكثر الحاكم من المراسيم، يظنّ أنه يضبط إيقاع البلاد.
لكنّ البلاد — كما يقول الحكماء — لا تُضبط بالمراسيم، بل بالناس.
وإذا كان المواطن لا يعرف وزيره اليوم، فقد يأتي الغد الذي لا يعرف فيه رئيسه أيضًا،
حينها لن يحتاج الشعب إلى مرسومٍ جديد، بل إلى إعلان ميلادٍ جديد لفلسطين… تُكتب فيه الأسماء من الأسفل إلى الأعلى.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96094