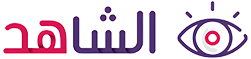ياسر عرفات.. القائد الذي خانته البنادق التي صنعها!

رام الله – الشاهد| محمود كلّم: في التاريخ الفلسطيني، لا اسم يعلو على اسم ياسر عرفات، ولا سيرة تختصر الحلم والخذلان كما تختصرها سيرته.
هو الرجل الذي خرج من بين ركام النكبة ليبني ثورة، ومن بين رصاص الاحتلال ليبني هوية. كان قائداً بحجم وطنٍ لا يشبه إلا جرحه، وزعيماً حمل الكوفية كأنها راية مقدسة، ونام على خريطة فلسطين كأنها وسادته الأخيرة.
وُلد ياسر عرفات عام 1929، في القدس أو في القاهرة، لا فرق؛ فالرجل منذ البداية كان ابن فكرةٍ لا ابن مكان. درس الهندسة، لكنه قرر أن يبني شيئاً أعظم من الأبنية: بنى الثورة الفلسطينية الحديثة.
أسّس مع رفاقه حركة “فتح” عام 1965، لتكون النواة الأولى للمشروع الوطني الفلسطيني، وأطلق الرصاصة الأولى باسم شعبٍ قرّر ألّا يموت بصمت.
ومنذ أن نطق باسم فلسطين، بدأت الحرب عليه: حربٌ من الخارج، وأخرى من الداخل.
الاحتلال لاحقه في كل مكان: من الأردن إلى لبنان، ومن تونس إلى رام الله. لكن الأصعب من العدو كان الصديق الذي خانه، والرفيق الذي باعه، والذين تسلّلوا إلى الثورة بأسماءٍ مستعارة ليغرسوا خناجرهم في قلبها.
كان عرفات، في كل محطّاته، يرى كيف تتسلّل العمالة إلى الصفوف تحت راياتٍ وطنية، وكيف تحوّلت الثورة من مشروع تحريرٍ إلى مسرح صفقات.
حين اشتدّ الحصار عليه في بيروت عام 1982، قالها بمرارة: “يريدون أن يطردوني من بيروت كما طردوني من عمّان، لكني لن أخرج إلا شهيداً أو منتصراً.”
خرج من بيروت مرفوع الرأس، لكنه حمل معه جرحاً عميقاً؛ جرح الرفاق الذين باعوه ليفتحوا أبواب التفاهم مع العدو.
ومع توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بدا أن الحلم يتحوّل إلى دولة، لكن الحقيقة كانت أكثر مرارة.
أوسلو لم تُعِد لعرفات الوطن، بل أعادته إلى سجنٍ كبيرٍ اسمه رام الله.
صار رئيساً محاصراً في المقاطعة، محاطاً بمن سماهم “الأبناء”، لكن كثيراً منهم كانوا أدواتٍ في يد الاحتلال.
كان يعرف أنهم ينقلون أنفاسه، ومكالماته، وطعامه.
كان يعرف أنّ الموت قادمٌ لا محالة، لكنه اختار أن يبقى؛ اختار أن يُحاصَر في وطنه على أن يعيش مكرّماً خارجه.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2004، جاء الغدر على هيئة مرضٍ غامض.
سمٌّ تسلّل إلى جسده كما تسلّل الخنجر إلى الثورة يوماً.
سقط القائد الذي لم يسقط في معركة، وسقطت معه مرحلةٌ من أنبل مراحل الكفاح الفلسطيني.
لم تُكشَف الحقيقة بعد، لكن الجميع يعرف: ياسر عرفات(أبو عمار) لم يمت، بل اغتيل.
اغتاله من خاف من صلابته، ومن ضاق بصوته، ومن أراد لفلسطين أن تُفرّط في آخر رموزها.
رحل ياسر عرفات(أبو عمار)، لكن ظلَّه بقي يطوف في الأزقة والمخيمات.
بقيت كوفيته راية، وصوته في الميادين نداء: “على القدس رايحين، شهداء بالملايين.”
كان مؤمناً أنّ الثورة فكرةٌ لا تموت، وأنّ الشعب الذي يحبّ الحرية لا يُهزم، مهما تكاثر عليه الغدر.
اليوم بعد أكثر من عقدين على رحيله، ما زالت الأسئلة مفتوحة، والوجع حاضراً:
من الذي دسّ السم؟ من الذي سلّم المقاطعة للجلاد؟ من الذي تآمر مع العدو لينهي حياة قائدٍ رفض الانحناء؟
قد لا تأتي الإجابة، لكنّ التاريخ لا ينسى.
سيكتب أنّ ياسر عرفات (أبو عمار) كان آخر من آمن أنّ البندقية يمكن أن تكون شريفة، وأنّ الخيانة يمكن أن تلبس الكوفية وتتكلّم بلسان الوطن.
اليوم تحتفل حركة “فتح” باغتيال قائدها الأول، على يد قادتها الحاليين، بحسب روايتهم أنفسهم عن السمّ الذي وُضع له في الطعام.
حركةٌ قضى معظم قادتها بتصفياتٍ داخلية، وقتلت من أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات أضعاف ما قتلت من العدو، نتيجة انقساماتها وصراعاتها وسرقة الطلقة التي لم تُطلَق، لتنسبها لنفسها وتعيش على إنجازات الآخرين.
اختطفت الشعب الفلسطيني في سياقها لأكثر من ستين عاماً، وما تزال الخنجر المسموم في خاصرته.
إحدى وعشرون سنة من الاحتفال باغتياله… ومن الاستماتة في الدفاع عن قاتليه.
وربما كانت مأساته الكبرى أنه أحبّ فلسطين أكثر من نفسه، وأحبّ شعبه حتى حين خانه بعضه.
رحل جسداً، لكنه بقي وطناً حيّاً في ذاكرة كلّ من لا يزال يؤمن بأنّ الحرية لا تُشترى، وأنّ القائد الذي مات واقفاً لا يُدفن إلا في قلوب شعبه.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96701