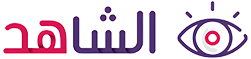عن مصطلح “حاكم غزة” وأبعاد التجربة السياسية

رام الله – الشاهد| كتب إيهاب بسيسو: إن مجرد القبول بمصطلح “حاكم غزة” أو الترويج له إعلامياً بهدف التداول الشعبي، يعد كارثة بحد ذاتها، فالمصطلح يشير في ثناياه إلى استحداث تجربة سياسية بالغة الخطورة، تكون منفصلة في مكوناتها الوظيفية وآلية تنفيذها عن الإرث التاريخي والوطني للقضية الفلسطينية، بمعنى المزيد من تقزيم الحالة الراهنة، والإمعان في عزلها التدريجي عن سياقها النضالي تاريخياً وسياسياً، وذلك من خلال الإشارة إلى استحداث حالة وظيفية جديدة ضمن مفهوم التفتيت الممنهج للكينونة الفلسطينية وتحويل هذه الكينونة المنهكة استعمارياً إلى جملة من القضايا الفرعية ذات الحمولة الاقتصادية والاجتماعية.
“حاكم غزة” تعني أن نجاح هذه التجربة (إن قُدر لها النجاح، مع الشك في ذلك) يمكن تمريرها جغرافيا بعد ذلك كحل سحري “للمعضلة الفلسطينية” حسب الرؤية الدولية مع توافقات اقليمية ودولية محتملة أو كلاهما معاً، فلا مانع إذاً من أت يكون بعد ذلك منصب حاكم للضفة، للتغلب على معضلة “عدم الاستقرار الاقتصادي في ظل تعمق الأزمة المالية”.
ولو تمادينا في المخيلة قليلاً، فلا مانع من حاكم للخليل، وحاكم لنابلس وحاكم لجنين. وهنا تكمن خطورة المصطلح بدلالاته السياسية المحتملة، والتي تقدم الحل المناطقي بديلاً للحل الوطني الشامل (وهذا ليس جديداً على الأقل، فقد سبقه محاولات عدة في ذات المسار، ولم تكلل بالنجاح).
غير أن طرح المصطلح هذه المرة وفي هذا التوقيت السياسي وبهذا الشكل المتعمد في أن يكون مستفزاً، على طريقة إحداث الصدمة المفاجئة أو إطلاق بالون الاختبار السياسي، يعني أن الحل التفتيتي للقضية الوطنية أصبح “ورقة سياسية مطروحة على الطاولة”.
غزة ليست بحاجة إلى “بريمر محلي” بغطاء دولي مثل ما حدث في العراق إبان حرب ٢٠٠٣ وتعيين بول بريمر حاكماً للعراق لفترة انتقالية، وليست بحاجة إلى “سرَّاج فلسطيني” كما حدث مع تعيين عبد الحميد السراج في عام ١٩٦٠ رئيساً للمجلس التنفيذي لإقليم الشمال (سوريا) إبان الوحدة بين مصر وسوريا في عهد عبد الناصر.
كل التجارب الشبيهة أو ذات الصلة، على مر التاريخ الحديث باءت بالفشل الذريع والنتائج العكسية الكارثية.
غزة بحاجة إلى أن تظل في قلب الحراك السياسي الفلسطيني وضمن الرؤية الوطنية الفلسطينية النابعة من وحدة الجغرافيا والمصير فعلاً وليس قولاً وشعارات فقط.
من الطبيعي أن يثير مصطلح “حاكم غزة” أو مصطلح “اليوم التالي” حالة من التفاعل خصوصاً مع اقتراب حرب الإبادة من العامين والتدمير الشامل لقطاع غزة، غير أن هذا هو السراب السياسي بكل تجلياته ووضوحه الانتهازي الدولي في خلط الأمور واللعب على الوتر الانساني، في ظل المجازر اليوميم وجرائم التجويع، بدلاً من الضغط الدولي الجاد نحو وقف الإبادة فوراً.
إن “اليوم التالي” فلسطينياً هو جوهر القضية في التخطيط والمبادرة السياسية.
فالقضية ليست في اختيار أسماء بعينها أو شخصيات اعتبارية أو كفاءات وطنية أو اقتصادية فلسطينية، بقدر ما هي في ضرورة إنقاذ الحالة الفلسطينية من الاختناق الذاتي، والاختناق السياسي العام عبر رؤية جادة وعميقة تشمل الكل الفلسطيني.
ولعل تصريحات الأستاذ الصديق سمير حليلة مؤخراً لإذاعة أجيال المحلية، والتي تم تداولها بشكل واسع، تحمل في طياتها الكثير من الأجوبة حول طبيعة الاتصالات والحراك الاقليمي والدولي غير المعلن رسمياً على الأقل خلال الأشهر الماضية، وهذه بحد ذاتها مسألة بالغة الأهمية لقراءة المشهد الدولي بعمقه السياسي بعيداً عن التسطيح الإعلامي المعتاد.
كما أن المسألة ليست في طبيعة أو شكل أو حجم المبادرات المحلية أو الدولية، وما تحمله من رؤية المستقبل الفلسطيني في ضوء التحديات الكبرى، فحجم الحراك السياسي غير الثابت، يمكن قراءته أيضاً في سياق التحفيز الضروري على بلورة رؤية وطنية جادة وقادرة على الاستفادة من كل الامكانيات المتاحة سياسياً واقتصادياً على حد سواء، ضمن قاعدة وطنية صلبة، تأخذ بعين الاعتبار عمق الخطر الوجودي الذي يشكل التحدي الأبرز زطنياً ومفصل التحول السياسي في المستقبل.
بقي القول، إن سياسة التفريغ الديمواغرفي سواء في غزة أو القدس أو الضفة الغربية، والمصحوبة بتسريع وتيرة التمدد الاستيطاني، بالتزامن مع جرائم الاستيطان اليومية بحق الوجود الفلسطيني، تتطلب حيوية سياسية فلسطينية في هذه المرحلة بالذات والتي يرتكز عليها مستقبل القضية الوطنية أكثر من أي وقت قد مضى.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92397