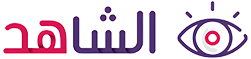في ضرورة محاكمة السلطة الفلسطينية ومحاسبتها

رام الله – الشاهد| كتب كريم قرط.. من الطبيعي في المرحلة الحالية أنّ تنتشر دعوات إعادة التفكير في خيار المقاومة وأنماطها ووسائلها، ومعها الدعوة إلى محاسبة المقاومة، لأسبابٍ موضوعيةٍ تتعلق بالأثمان والتكلفة الباهظة المترتبة على فعل المقاومة. لكن؛ هناك أسبابٌ أخرى تتلطى خلف الموضوعية، وتتصدر المشهد في الدعوة إلى محاسبة المقاومة ومحاكمتها، من تلك الأسباب “أن الثور إن وقع كثرت سكاكينه” كما يقال، فعقب الضربات القاسية التي تعرضت لها المقاومة الفلسطينية وظهيرها في “محور المقاومة”، تحول انتقادها ومهاجمتها إلى دلالةٍ على رجحان العقل والعقلانية، مع أن كُثرًا ممن يتزعمون هذا التوجه تغنوا في بدايات الحرب بالمقاومة، وانحازوا إليها، أو ظلوا صامتين بانتظار نتيجة الأمور، وهذا الأمر مفهومٌ أيضًا، فالانتصار، كما يقال، له ألف أبٍ، لكن الهزيمة يتيمةٌ.
ضمن السياق ذاته؛ تشنّ حملةٌ إقليميةٌ شاملةٌ على كلّ قوى المقاومة، لا تتعلق بسلوكيات بعض قوى المقاومة أو أخطائها (حسب الاصطفاف السياسي والأيديولوجي في منطقتنا وسلوك الأطراف الأخرى)، إنّما تتعلق بجوهر مفهوم المقاومة نفسه، ضمن تصوراتٍ إقليميةٍ لمستقبل المنطقة، يمكن اختصارها، إن أحسنا الظن، بالمثل الشعبي “اليد التي لا تقدر عليها، قبّلها”، ولربما أبعد من ذلك كـ”تقبيل القدم” مثلاً أو شيء غيرها. وضمن السياق نفسه؛ يجب التخلص من المقاومة، وتحميلها تبعات كوارث المنطقة كلّها، بما فيها مسؤولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي ورعاته، سواء في فلسطين أو لبنان أو اليمن، أو أيّ بقعةٍ يعتدي عليها الاحتلال.
تبرز مسألة الذرائع التي تتهم المقاومة بأنّها أعطتها للاحتلال لتنفيذ جرائمه، ولذلك، فهي لدى أصحاب هذا التوجه تتحمل مسؤولية الإبادة الجماعية والحصار والتدمير، لذا يطالبون بسحب الذرائع من الاحتلال، وتسليمه أسراه، كي نتقي شره، ونكف أذاه عنا. في سياقاتٍ أخرى؛ يطالب بوقف الإسناد، أو نزع السلاح، أو القبول بالاحتلال المباشر حتّى تسحب الذرائع من يد الاحتلال! ولا يهم بعدها إن استمر بعدوانه وجرائمه أم توقف عنها، المهم ألا نعطيه أيّة ذريعة، وربّما عاد بعد زمنٍ واعتبر وجودنا بحدّ ذاته ذريعةً لعدوانه وجرائمه وإبادته، ولا نعلم حينها كيف سنسحب الذرائع من يده!
تتربع السلطة الفلسطينية، بمنظومتها كلّها، على رأس قائمة الداعين لمحاسبة المقاومة قولًا وفعلًا، فالسيد الرئيس لا يترك مقامًا إلّا ويبذل أقصى جهده فيه لتحميل المقاومة مسؤولية جرائم الاحتلال، حتّى لو كان الوقت المتاح له لا يتعدى الدقائق الثلاث، كما في اجتماع القمة العربية الثالثة والثلاثين في مايو/أيّار 2004، حينها لم يفوت فرصة الهجوم على المقاومة وتحميلها مسؤولية جرائم الاحتلال، واتهامها بتقديم الذرائع له. أما عمليًا، فبعيدًا عن تكوين السلطة الوظيفي، خصوصًا من الناحية الأمنية، فقد ضاعفت خلال الحرب جهودها في قمع المقاومة، والحركات أو التحركات الشعبية، وصولًا إلى شن حملةٍ أمنيةٍ على مخيّم جنين في ديسمبر/كانون الأول 2024، تحت مسمى “حماية وطن”، أدت إلى تخصيب البيئة لقوات الاحتلال لتشن بدورها عمليةٍ عسكريةٍ على شمال الضفّة الغربية، بعد أيّامٍ من عملية السلطة، كما استمرت السلطة بسحب الذرائع من الاحتلال باعتقالها عشرات المطاردين والمقاومين، في تكاملٍ عضويٍ مع عملية الاحتلال. بل حتّى على مستوى الدلالة الرمزية للتسمية، رسخ الهجوم على المقاومة، تحت عنوان “حماية الوطن”، تصوير المقاومة بأنّها مدمر الأوطان بدلاً من جرائم الاحتلال والاستيطان والتهجير، ومجمل سياسات الاحتلال، التي هي في الأصل سبّاقةٌ على بروز المقاومة، التي لا تظهر إلّا رد فعلٍ عليها، لا فعلًا منبت السياق ومنعزلٌ عن الأسباب.
في مقابل الخطاب الذي ترفعه السلطة بضرورة محاسبة المقاومة على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، ألا تحق لنا المطالبة بمحاسبة السلطة ومحاكمتها، والتحقيق في مجمل الأخطاء والخطايا الكارثية التي حلت بالشعب الفلسطيني جرّاء سياساتها، التي تقوم للمفارقة على فكرة سحب الذرائع من يد الاحتلال وعدم إغضابه. لن نعود إلى الوراء كثيرًا لتقييم تجربة منظّمة التحرير، وما رافقها من أخطاءٍ كارثيةٍ في كلّ أرضٍ حطت فيها، أو مواقفها التي أدت إلى تبعاتٍ كارثيةٍ على الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، مع أن فيها أمراضًا مزمنةً تنتقل بالوراثة، ظلّت مرافقةً للمشروع الوطني الفلسطيني برمته حتّى يومنا هذا، وأهمّها، التي ينبع عنها ما سواها، حالة التفرد والأبوية لدى شخص القائد أو الزعيم، الذي يؤمن بأنّه يرى ما لا يراه غيره، وبأنّه يحتكر الفهم والحكمة، علاوةً على احتكاره القرار والهيمنة على المؤسسات والموارد المادية. لكن، لا بدّ من المرور على أوسلو، كونه من أهمّ وأخطر المحطات المفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية.
لم تذهب منظّمة التحرير إلى اتّفاق أوسلو بقرارٍ منفردٍ من حركة فتح فحسب، إنما بقرار حلقةٍ ضيقةٍ من قيادة الحركة، عبر الالتفاف على مفاوضات واشنطن، التي كان يقودها حيدر عبد الشافي، ولم تصل إلى نتيجة الحدّ الأدنى، بسبب رفض الاحتلال تقديم أيّ تنازلٍ حقيقيٍ، خصوصًا ما يتعلق بالاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967. والأهمّ أن الاتّفاق كان منعزلًا عن إرادة الشعب الفلسطيني، الذي لم يكن له رأي فيه أو يستفتى بشأنه، رغم أنّه اتّفاقٌ لهندسة مصير الشعب الفلسطيني وواقعه ومستقبله. فقد أعاد الاتّفاق تعريف الشعب الفلسطيني وفلسطين نفسها، وأدى إلى إخراج فلسطيني الشتات واللجوء وأراضي 48 من تعريف فلسطين الجديدة، التي أصبحت تنحصر بأراضي الـ67، أو أجزاءٍ منها فقط. صحيحٌ أن منظّمة التحرير كانت الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ما يمنحها تفويضًا ضمنيًا للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، لكن جوهر التفويض وشرعية التمثّيل تلك تتعلق بالمطالبة بالحقوق الفلسطينية، ومحاولة استعادتها، لا بالتنازل عنها أو عن معظمها، كما أنّ التعلل بالوضع الإقليمي والدولي للقول بأنّه الحلّ الوحيد الممّكن ليس مبررًا للتنازل عن حقوق شعبٍ كاملٍ، بل وعن رأيه بهذا الخصوص، فعجزك عن استعادة الحقّ الموكّل به لا يخولك التنازل عنه بتاتًا.
لو أنّ الإشكالية وقفت عند هذا الحدّ، لكان من الممكن التغاضي عنها مقابل إنجازٍ سياسيٍ لجزءٍ من الشعب الفلسطيني، لكن تمام الكارثة كان في الواقع السياسي الذي أعقب اتّفاق أوسلو، الذي أصبح مأزقًا فلسطينيًا مزمنًا، يبدو أنّ الانفكاك منه، أو التفكير خارج إطاره، يميل إلى الاستحالة. إذ أصبح المأزق هذا القاعدة في المشهد الفلسطيني بعد تسلم الرئيس محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية، التي عمل على تحويلها رويدًا رويدًا إلى ما يشبه الشركة الخاصّة المحدودة، التي يديرها مجلس إدارةٍ ضيقٍ، كمقاولٍ من الباطن لدى الاحتلال.
خلال هذه المرحلة عملت السلطة، لا في جزءٍ من دورها الوظيفي فحسب إنّما في سبيل بقاء “الشركة ومُلّاكها وأرباحها”، على ضرب بنية المجتمع الفلسطيني بسياساتٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وأمنيةٍ حولته من شعبٍ منخرطٍ ومتفاعلٍ مع قضاياه الوطنية إلى شعبٍ بينما يباد جزءٍ منه وتشن عملياتٍ عسكريةٍ على جزءٍ آخر، يستمر في ممارسة حياته باعتياديةٍ تحفزها السلطة وترعاها، مثل ما فعلت في حفل افتتاح أحد المولات في رام الله.
في السياق ذاته، عملت السلطة، كما هو معلوم، على تفكيك بنى الشعب الفلسطيني التنظيمية والتعبوية، ومؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها منظّمة التحرير، ولاحقت عمل الفصائل الفلسطينية التنظيمي، وجعلته حكرًا على حركة فتح، التي تحولت إلى حزب سلطة، وظيفته تأمين الولاء، وتعميق الهيمنة على المؤسسات العامة. كما عملت على قمع المجتمع ومنعه من ممارسة حقوقه السياسية والوطنية، سواء فيما يتعلق بإدارة السلطة، أو النظام السياسي الذي فرض عليه، أو في ما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال وحقّه الأصيل في مقاومته. إضافةً إلى سلب إرادة الناس بوسائل مختلفة، منها تعطيل المجلس التشريعي وحله نهائيًا، وإلغاء الانتخابات العامة، وهندسة الانتخابات المحلية والنقابية على مقاس السلطة، ومحاربة الهيئات التي لم يفز فيها حزب السلطة لإفشالها. علاوةً على إفشال المصالحة، أو إنهاء الانقسام، من خلال الإصرار الدائم على إجبار فصائل المقاومة الفلسطينية على تقديم تنازلاتٍ مجانية للاحتلال، مثل نزع السلاح، تحت شعاراتٍ يظن من يسمعها أن السلطة دولةٌ بحقّ ولها سيادةٌ، من قبيل “حصر السلاح بيد الدولة”، و”السلاح الشرعي” وغيرها، إضافةً إلى الاشتراط أنّ تعترف الفصائل الفلسطينية باتّفاق أوسلو وبـ”الشرعية الدولية” وقراراتها شرطًا لدخولها المنظّمة.
لم تقتصر هذه السياسات الهدامة على الضفّة الغربية، بل امتدت إلى قطاع غزّة، الذي فرضت عليه عقوباتٌ ماليةٌ واقتصاديةٌ، ووقفت ضدّ مشاريع كان بإمكانه تخفيف حدّة الحصار الإسرائيلي، منذ أن بدأ الانقسام حتّى قبيل حرب الإبادة الجماعية على القطاع. مع أنّ الفئة الأساسية المستهدفة بالعقوبات كانت تلك المنتمية والمحسوبة على حركة فتح وموظفيها السابقين، فإنّ ذلك لم يكن له أيّ اعتبارٍ لدى قيادة السلطة، التي تعاملت مع خصمها السياسي على أنّه “العدو”.
استمرت السلطة الفلسطينية في سياساتها تلك حتّى مع الحرب المفروضة على الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب عشرين شهرًا، إذ لم تنظر السلطة الفلسطينية إلى الإبادة الجماعية، وسعي الاحتلال الحثيث إلى حسم الصراع وتهجير الشعب الفلسطيني على أنّه فرصةٌ للإصلاح والمصالحة والتوحد في مواجهة تلك التحديات الوجودية، بل على العكس؛ ضاعفت السلطة جهودها في تدمير المجتمع الفلسطيني، وملاحقة قواه المقاومة، والأخطر أنّها انضمت إلى حملة الدعاية الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني، بقضها وقضيضها، وهذه جريمةٌ تصل إلى حدّ المحرمات الوطنية، لأنّها تشرع جرائم الاحتلال، وتمنحه سندًا من طرفٍ “فلسطينيٍ” كي يستخدمه الاحتلال في مواجهة الانتقادات الدولية، ومطالب المحاكمة على جرائمها. ولمزيدٍ من الانفصال عن الواقع، وعن الشعب وهمومه، تمرّ السلطة حاليًا بمرحلة تقسيم التركة، وتوزيع الأدوار والمناصب، بلا أيّ اعتبارٍ للكارثة الوطنية التي نمر بها، أو بالإرادة الشعبية، أو التوافقات الفصائلية.
في المحصلة، مارست السلطة الفلسطينية خطايا كارثية بحقّ الشعب الفلسطيني وقضيته، ولا مبالغة في القول إن موقف السلطة برئاسة الرئيس عباس، الرافض لأيّ صيغة توافقية لبرنامج وطني نضالي شامل تلتقي عليه القوى الفلسطينية كافّة، كان أحد العوامل التي دفعت المقاومة إلى خيار “طوفان الأقصى”. فإنّ قبلنا بخطاب السلطة الذي يحمل المقاومة وزر جرائم الاحتلال، فعلينا أن نحاسبها ونحاكمها مقابل كلّ دونم أرضٍ يصادر، أو بيتٍ يبنى في مستوطنةٍ في الضفّة الغربية، هذا ليس من باب المناكفة، إنّما لأنّ مشروع السلطة برمته قائمٌ على تمكين المشروع الاستيطاني، ومن قبل بهذا المشروع ولم يتدارك خطأه بعد ما تبين له الحقّ هو شريكٌ في الجريمة ذاتها.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=88881