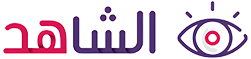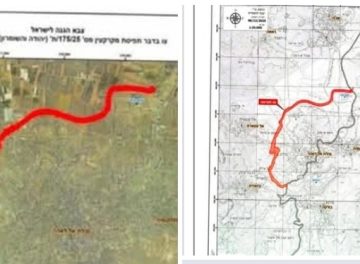أبعد من الإعلان الدستوري: هندسة للنظام السياسي الفلسطيني

رام الله – الشاهد| كتب: د. عمر رحال: لم يكن الإعلان الدستوري الفلسطيني الأخير مجرد خطوة دستورية أو إدارية في سياق إصلاح النظام السياسي، وبصرف النظر عن مدى دستورية الإعلان الدستوري ، وذلك استناداً للمادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني،التي تتحدث عن شُغور مركز رئيس السلطة الوطنية.بل شَكّل لحظة سياسية بالغة الدلالة، تكشف حجم الضغوط الدولية والإقليمية التي تسعى إلى إعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني بما يخدم مصالح خارجية أكثر مما يخدم المشروع الوطني.
فخلف الخطاب المعلن من بعض الدول عن “الإصلاح” و”الشفافية” و”تجديد الشرعية”، تكمن إرادة دولية واضحة في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بطريقة تضمن استمرار السيطرة الغربية، وتبقي إسرائيل في موقع الهيمنة.
من هنا، لا يمكن فهم هذا الإعلان بمعزل عن شبكة العلاقات والمصالح المتشابكة التي تمتد من باريس إلى واشنطن، ومن بعض العواصم العربية إلى تل أبيب، في محاولة لإنتاج “نظام فلسطيني جديد” يكون أكثر قابلية للتكيف مع المرحلة المقبلة، وأقل تمسكاً بثوابت التحرر والاستقلال.
يبدو أن الغاية الأساسية من الإعلان الدستوري لا تقتصر على تنظيم المرحلة السياسية المقبلة، بل تمتد إلى ما هو أعمق، تأمين انتقال سلس للسلطة وفق رؤية إقليمية – دولية، تضمن استقراراً شكلياً دون تغيير جوهري في موازين القوى أو في طبيعة الصراع مع الاحتلال.
فالمقترح المتداول يفهم منه أنه سيكون هناك خروجاً للرئيس من المشهد السياسي الفلسطيني ، يعقبه تسلم نائب الرئيس مهام الحكم لفترة انتقالية تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية أو تشريعية.
هذا الترتيب، وإن بدا دستورياً في الشكل، إلا أنه في الجوهر محاولة لتفريغ الإرادة الفلسطينية من مضمونها الشعبي، وإخضاعها لمنطق “الاستقرار الموجّه”، بحيث تبقى مؤسسات الحكم في حالة تبعية للمجتمع الدولي، لا سيما في ظل انقسام داخلي مزمن، وغياب أفق سياسي واضح.
مع التأكيد أننا مع إجراء الانتخابات الدورية ومع مبدأ التداول السلمي للسلطة، ومع ضرورة ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية الفلسطينية بما يعزز المشاركة والتجديد.
هذا إلى جانب الالتزام الكامل بقبول نتائج صناديق الاقتراع التي تعبر عن الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني، باعتباره مصدر السلطات وصاحب الحق الأصيل في اختيار من يمثله ويقود مسيرته الوطنية.
اليوم تتقدم بعض الدول الأوروبية الصفوف في الضغط على القيادة الفلسطينية، تحت شعار “إصلاح مؤسسات الحكم” و”تجديد الشرعيات”.
غير أن هذا الضغط لا ينفصل عن مصالح إستراتيجية فرنسية – أوروبية، تسعى إلى لعب دور الوسيط في مرحلة ما بعد الصراع، وإلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط عبر البوابة الفلسطينية.
وفي الوقت ذاته، تمارس بعض الدول العربية ضغطاً موازياً، إذ ترى في أي انتقال سياسي في رام الله فرصة لإعادة ترتيب علاقاتها مع إسرائيل عبر إطار “التطبيع المقنع”، بحيث يتم إعادة إدماج الاحتلال في الإقليم تدريجياً من خلال تسوية فلسطينية “مقبولة دولياً”.
إن الحديث عن “إصلاحات سياسية” يبدو في بعض الأحيان غطاءً لصفقة أوسع هدفها تهيئة الساحة الفلسطينية لمرحلة ما بعد الرئيس عباس.
ليست هذه الموجة من الضغوط جديدة، فمنذ عام 2002، حين أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ما سمي بـ “خطة الإصلاح الفلسطينية” في سياق “خريطة الطريق”، بدأ الحديث الأمريكي – الأوروبي عن ضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية وانتخاب “قيادة جديدة تؤمن بالسلام”.
كان الهدف المعلن هو “الشفافية والمساءلة”، أما الهدف الخفي فكان إعادة تشكيل القيادة الفلسطينية بما يتناسب مع متطلبات المفاوضات ومع رؤية واشنطن للسلام القائم على الأمن الإسرائيلي أولاً.
تلك الضغوط أدت إلى تغيير جوهري في بنية النظام السياسي الفلسطيني، أبرزها استحداث منصب رئيس الوزراء عام 2003، وتقييد صلاحيات الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف موجات “الإصلاحات القسرية”، بل أخذت طابعاً أكثر تعقيداً مع كل أزمة داخلية أو مرحلة انتقالية جديدة.
قد نجد تشابهاً بين الحالة الفلسطينية الراهنة وتجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حين قُسمت البلاد إلى شرقية وغربية، وفرضت القوى المنتصرة عليها دستوراً جديداً ومناهج تعليمية تضمن “عادة تأهيل الوعي الوطني”.
اليوم، يبدو أن بعض العواصم الغربية تتعامل مع الفلسطينيين بذات المنطق، إعادة تشكيل البنية السياسية والفكرية للمجتمع الفلسطيني، وإعادة تعريف مفهوم “الشرعية” و”المقاومة” و”الدولة” بما يتوافق مع مصالح الغرب وإسرائيل.
لكن الفارق الجوهري أن ألمانيا كانت دولة مهزومة في حرب عالمية، بينما الشعب الفلسطيني صامداً صابراً مرابطاً، يواجه الاحتلال بعزيمة لا تلين، كما أنه ضحية استعمار استيطاني لا يزال يحتل أرضه، ويقوض حقه في تقرير مصيره. وبالتالي، فإن فرض نماذج دستورية أو تعليمية أو سياسية من الخارج يشكل استمراراً لسياسة الهيمنة لا خطوة نحو الاستقلال.
لذلك يحاول الخطاب الدولي الإيحاء بأن الأزمة الفلسطينية داخلية بحتة، وأن القيادة الفلسطينية هي المسؤولة عن “تعطّل العملية السياسية”.
لكن الحقيقة أن المشكلة الجوهرية تكمن في الموقف الغربي نفسه، الذي يرفض التعامل مع جذور الصراع بوصفه احتلالاً يجب إنهاؤه، ويفضّل إدارته بوسائل “نظامية” لا تمس جوهر الهيمنة الإسرائيلية.
الرئيس محمود عباس، رغم كل الانتقادات الداخلية، تبنّى نهجاً تفاوضياً وسلمياً منذ توليه السلطة، كما أنه رفض التفاوض في ظل الاستيطان والقتل والتوسع ، وواجه صفقة القرن بقوة وعزيمة وبرفض وطني ، في الوقت الذي أذعنت بعض الدول لإملاءات ترامب، ومع ذلك لم تحصد السلطة الفلسطينية سوى المزيد من التهميش السياسي وتوسع الاستيطان والقتل ومصادرة الأراضي وسرقة أموال الشعب الفلسطيني ، والتحلل من الاتفاقيات.
إن الخلل البنيوي ليس في القيادة الفلسطينية بل في المنظومة الدولية التي تكافئ المحتل وتعاقب الضحية، وتطالب الفلسطينيين بإصلاحات لا تعنيها سوى في حدود حفظ “الاستقرار الأمني” لإسرائيل.
ورغم الترحيب الفلسطيني بالاعترافات الأوروبية المتزايدة بدولة فلسطين، إلا أن هذه الاعترافات، في غياب إجراءات سياسية حقيقية، تظل رمزية لا تغيّر من الواقع شيئاً. فالاعتراف لا يتحول إلى سيادة ما لم يترجم بخطوات عملية، مثل الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة، أو فرض عقوبات على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.
إن الاعتراف، في صورته الحالية، يستخدم كأداة ضغط ناعمة أكثر منه كوسيلة دعم فعلي لحق تقرير المصير، وهو ما يجعل الفلسطينيين في حلقة مفرغة من “الاعترافات الشكلية دون التحرر الحقيقي”.
في كل مرة تطرح فيها مبادرة لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، نجد أن البوصلة تأتي من الخارج وتربط الإصلاحات السياسية والمالية بشروط التمويل والمساعدات، فيتحول القرار الوطني إلى رهينة للإرادة الدولية.
حتى موضوع المناهج التعليمية والإعلان الدستوري يدخل ضمن هذه المنظومة من الضغوط، حيث تستخدم “لغة الإصلاح” لتبرير إعادة صياغة الوعي السياسي الفلسطيني بما يتلاءم مع مفهوم “السلام الاقتصادي” و”الواقعية السياسية”. بهذا المعنى، تتحول الإصلاحات إلى ابتزاز سياسي ، يراد منه هندسة النظام السياسي الفلسطيني بحيث يكون تابعاً للمنظومة الإقليمية والدولية، لا مستقلاً عنها. فالمطلوب ليس إصلاح السلطة من الداخل، بل ضبطها لتكون أداة تنفيذية للسياسات الغربية في المنطقة.
ويبقى السؤال الجوهري، كم سننتظر من العقود والسنوات حتى نرى الدولة الفلسطينية المستقلة؟ لقد مضى أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاق أوسلو وأربع وثلاثون عاماً على مؤتمر مدريد للسلام، وما زالت الدولة مؤجلة. تتغير الخطط والمبادرات، وتتبدل الوجوه، لكن الاحتلال باقٍ، والوعود تتكرر دون سقف زمني أو التزام فعلي.
الدول التي تضغط من أجل “إصلاحات فلسطينية” لا تقدم في المقابل خطة زمنية واضحة لإنهاء الاحتلال، ولا آليات لضمان قيام الدولة، لأنها ببساطة لا تريد تغيير موازين القوى الراهنة.إن الهدف الحقيقي هو إبقاء الفلسطينيين في وضعية الانتظار الدائم، بين تسوية مؤجلة، وإصلاحات شكلية، ومساعدات مشروطة.
لذلك ليست القضية في “الإعلان الدستوري” ولا في “الإصلاح السياسي” بحد ذاته، بل في من يحدد اتجاه الإصلاح وغايته. فحين تأتي الدعوات من الخارج محمّلة بالأجندات، تتحول من أدوات بناء الدولة إلى أدوات هندسة سياسية خاضعة.
إن الطريق إلى الدولة الفلسطينية المستقلة لا يمر عبر بوابة الإملاءات الأجنبية، ولا عبر دستور يكتب في فلسطين ويُراجع في بعض العواصم الغربية، بل عبر إرادة وطنية حرة تضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبار، وتعيد تعريف الإصلاح بوصفه مشروعاً للتحرر، لا أداة للسيطرة.
وعلى الرغم من كثرة التحليلات والدراسات التي تحاول استشراف مستقبل المشهد الفلسطيني، تبقى الحقيقة أن الساحة الفلسطينية عصيّة على التنبؤ، ومفتوحة على احتمالات لا يمكن ضبطها ضمن منطق السياسة التقليدية أو أدوات التحليل الأكاديمي. فالوضع الفلسطيني يشبه رمال الصحراء المتحركة، لا يستقر فيها شيء على حاله ، تتبدّل فيها التحالفات، وتتداخل فيها المسارات، وتتسارع فيها الأحداث على نحو يجعل الفهم الكامل للمشهد مهمة شبه مستحيلة.
هذه الديناميكية الفائقة لا تعكس فقط هشاشة البنية السياسية الفلسطينية، بل أيضاً حجم التدخلات الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية التي تشكّل محركات خفية تؤثر في اتجاهات التطور السياسي والاجتماعي.
إن المراقب أو المحلل أو الباحث في الشأن الفلسطيني يجد نفسه أمام لوحة معقدة تتجاوز حدود التحليل المنطقي، فكل حدث محلي يحمل في طياته أبعاداً إقليمية ودولية، وكل تفصيل داخلي هو انعكاس لتوازنات تتجاوز الجغرافيا الفلسطينية ذاتها.
لذلك، فإن صعوبة التنبؤ لا تعود إلى نقص في المعلومة أو ضعف في القراءة، وإنما إلى طبيعة الحالة الفلسطينية نفسها، التي تدار في كثير من الأحيان خارج منطق الدولة والسياسة التقليدية، وتتحرك وفق إيقاع الصراع الوجودي المفتوح منذ أكثر من سبعة عقود. ولذلك ستبقى الأيام المقبلة حُبلى بالمفاجآت.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96152