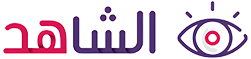سكت دهرا، ونطق هباء..حول تغيير السياسات الفلسطينية، خطابا وممارسة

صبري جريس – مدير مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت سابقا
أتحفنا “سيادة” (الشولتان حول كلمة سيادة هما للتحفظ، لا للتبجيل) الرئيس محمود عباس مؤخرا بتصريح غريب عجيب (نقلته وكالة الإنباء الفلسطينية، وفا، 14/2/2024)، لا يختلف كثيرا، في حقيقة الأمر، عن التصريحات التقليدية، التي اعتدنا على سماعها خلال سنين، والناجمة أساسا عن تفكير سياسي عقيم، جر الويلات على الشعب الفلسطيني ونضاله. والغريب أن يعود الرجل إلى إطلاق مثل هذه التصريحات بعد عملية “طوفان الأقصى”، وما تبعها من متغيرات إستراتيجية مهمة، يبدو أن عباس وصحبه غير قادرين على استيعابها (ولا بأس في ذلك، على أي حال، فليسوا هم من سيقررون لوحدهم في مصير القضية الفلسطينية بعد اليوم).
في مستهل تصريحه أعلن “سيادته”، بطريقة غير مألوفة: “إننا نطالب حركة ‘حماس’ بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948”.
ومثل هذا الكلام فارغ من اساسه، ويمكن تفسيره على انه نوع من محاولات الإحباط. ولكنه حقيقة لا يدل إلا على مدى جهل من يكرره بالتاريخ والسياسة. لقد وقعت نكبة 1948، كما قال عبد الناصر مرة، “في غفلة من التاريخ”. ولن “يغفل” التاريخ مرة ثانية، بعد أن تغيرت الأوضاع جذريا، ولن تحدث نكبة أخرى. يكفي أن نذكر، في هذا الصدد، انه ليست هناك ولو جهة واحدة في العالم بأسره تؤيد تهجير الفلسطينيين مما تبقى لهم من ارض. وحتى في إسرائيل نفسها راح الجميع، بما في ذلك كبار الفاشيين والعنصريين من أمثال سموتريتش وبن غفير، ينأون بأنفسهم عن استعمال عبارات التهجير ويتحدثون عما يسمونه “هجرة طوعية”. والكيان الصهيوني يتحسب كثيرا من مواقف الإجماع الدولي ضده في أية مسألة. وما أن يحدث ذلك حتى يتراجع. وحتى إذا نجح الإسرائيليون، لسبب لو لآخر، في تهجير بعض الفلسطينيين من هذه المنطقة أو تلك، فإنهم سيضطرون إلى إعادتهم، كما حدث في قلقيلية بعد حرب 1967، وفي مرج الزهور في جنوب لبنان سنة 1993.
ولكن الأمر، من هذه الناحية بالذات، لا يتوقف عند هذا الهراء. إذ لا يحق للرجل، المسمى رئيس دولة فلسطين، أيا كان المسمى فارغا، أن يتحدث، ولو همسا، عن خوفه مما يسميه تهجيرا، لأن مجرد هذه التلميحات تصب في مصلحة الأعداء من حيث زيادة “قناعاتهم” بشذوذهم وأوهامهم.
ولكن “درر” عباس لم تقف عند هذا الحد، إذ لا يستطيع إلا العودة إلى الجوز الفارغ، الذي دأب على إطعامنا إياه خلال فترة طويلة. فقد عاد “سيادته” إلى تكرار أقواله إياها: “نريد أن نحمي شعبنا من تداعيات أية كارثة خطيرة ستقع عليه، لذلك علينا أن نتخذ القرارات … لنستطيع الدفاع عن قضيتنا ومصالحنا الوطنية”.
تُرى متى استطاع “سيادته” حماية شعبه؟ وأين ومتى؟ وما هي السياسات التي اتبعها لتنفيذ ذلك؟ ولماذا هذا الكلام الأجوف؟ إن الرجل لم يستطع خلال مسيرته، وقطعا خلال رئاسته الميمونة، حماية قط أو ديك فلسطيني واحد، على الإطلاق، الإطلاق – بدون لف أو دوران. لقد أمعن “سيادته” في إقامة نظام تعاون امني مع إسرائيل، أي عمالة وتجسس امني لصالح الاحتلال, من خلال “تنسيق امني” وصفه مرة حتى بأنه “مقدس”، مع انه حقيقة في منتهى النجاسة. وهذا التعاون لم يكن معدّا لـ”حماية شعبنا”، بل لحماية عباس ونظامه، أولا وأخيرا. ففي ظل هذا النظام عاث الاحتلال فسادا في الضفة الغربية، من قتل واعتقالات واضطهاد ومصادرات واستيطان، وما شابه ذلك. وأخيرا أيضا أخذوا من السلطة حتى ميزانيتها وأموال شعبها (!). وخلال العشرين سنة الأخيرة، منذ أن استلم “سيادته” زمام السلطة، بعد استشهاد عرفات سنة 2004، تحولت ما تسمى “دولة فلسطين” إلى ما يمكن تسميته “مستعمرة إسرائيل الفلسطينية في الضفة الغربية”. إما “سيادة” رئيس دولة فلسطين فتحول عمليا إلى النائب الثاني لحاكم هذه المستعمرة، على اعتبار أن الحاكم الفعلي الرئيسي هو قائد القوات الإسرائيلية في الضفة, وإما نائبه الأول فهو رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة (وهو، في الآونة الأخيرة، ضابط درزي في الجيش الإسرائيلي، ونده لدى السلطة حسين الشيخ، الذي امتنع زملاؤه في اللجنة التنفيذية عن انتخابه لمنصب أمين سر اللجنة، فقام عباس … بـ … بتعيينه بقرار منه).
سياسة التنسيق، أي العمالة الأمنية هذه عادت بالكوارث، ليس على فلسطين فقط، بل على عباس نفسه أولا. فنتيجة للسياسة الخائبة التي اتبعها الرجل تعاظم استخفاف الصهيونيين به، وقرروا في نهاية الأمر حتى عدم الحديث معه في الشؤون السياسية – أي عمليا قاموا بشطبه. وليس من السهل إعادة الساعة إلى الوراء، وكل ما على القوى الوطنية عمله هو حصر عملية الشطب هذه بعباس وصحبه وحدهم ومنع اتساعها لتشمل الشعب الفلسطيني بأسره.
والحقيقة إن “الشطب” طال الشعب الفلسطيني بأسره، وبحدة بالغة. إن عملية قتل الفلسطينيين، على الطالع والنازل، في كل من غزه والضفة، ليست إلا دليلا قاطعا على مدى ذلك الاستخفاف العميق الذي تكنه لإسرائيل لكل من السلطة الفلسطينية وحماس سوية. وبدون إعادة الردع الفلسطيني لإسرائيل، في الصراع معها، لن تقوم للفلسطينيين قائمة.
لسبب ما، يصعب علي تحديده، حديث عباس عن “حماية شعبنا” يغيظني كثيرا، بل يؤلمني. ولا يغيظني بموازاته، أو أكثر منه، إلا حديث الصهاينة عن “الشعب المختار” و”الفوقية اليهودية”.
وبموازاة ذلك كله، وفي مقابله، لا يمكننا أن نعرف سر اهتمام عباس بالمفاوضات حول صفقة أو صفقات تحرير الأسرى، التي تعمل حماس على انجازها. لم نكن يوما من الحمساويين، وكثيرا ما انتقدناهم. إلا انه لا يبدو أنهم مخطئون كثيرا في مفاوضاتهم، بواسطة القطريين والمصريين، مع الأميركيين والاسرئيليين. أنهم يسعون للحصول على أحسن الشروط الممكنة. فماذا يضير عباس؟ بل ربما ينجحون في تحرير العديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومعظمهم من المناضلين القدامى الأشداء، الذين يمكن أن يغيروا طابع الحياة السياسية في فلسطين، ويفرزوا قيادات جديدة بدل الوجوه الشاحبة، التي “تسوقنا” منذ طلوع الفجر. وعلى كل حال، نعتقد أن حماس لن تأبه كثيرا بتصريحات”سيادته” – وهي على حق في ذلك.
وفي نهاية بيانه طالب “سيادته” عدم ازعاحه، مما قد يمنع “الاستمرار في هجومنا السياسي الشامل لدى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”. والحقيقة هي انه إن كان هناك من فضل لأحد في شن “هجمات شاملة” في المحافل الدولية فانه يعود لحماس دون غيرها، رغم أن الثمن كان باهظا وتمثل في الآلاف الشهداء، ولا لسياسة “المقاومة السلمية”، السخيفة والتافهة. فقبل “طوفان الأقصى” كانت شلل “سيلدنه” تتحدث عما تسميه “انسداد الأفق” (تُرى من أين يأتون بهذه العبارات؟)، دون أن تكون لديها الجرأة في الإعلان أن ذلك نجم عن (لا) سياسة “سيادته” العقيمة. والحال هذه تستحق حماس شيئا من الثناء العباسي لأنها أعادت الرجل إلى واجهة الاهتمام السياسي، ولو قليلا، على عينك يا تاجر.
ربما كان من الضروري إسداء النصح لعباس بأن يتطلع حوله بنظرة أكثر شمولية وعمقا على اعتبار انه قادر على الخروج من القوقعة التي يعيش ويفكر فيها. منذ بدأت غزوة “طوفان الأقصى” لم تحظ إسرائيل بجزء يذكر من أي انتصار يمكن الإشارة إليه، عدا عن الإغراق في حقد جرائم القتل التي تمارسها، والتي ينبغي أن تدفع ثمنها، محليا وشخصيا وعالميا. ولا يبدو أنها ستحصل على أي انتصار يذكر، مهما طالت الحرب. وعلى الرغم من أن الحرب على غزه تخف يوما وتشتد آخر، ليس هناك ضمان، من جهة أخرى، بألا تتوسع وتتحول إلى حرب إقليمية، خصوصا بعد أن عادت “الجبهة الشرقية” إلى الحياة. إن ما يقوم به حزب الله (وهو غير مصاب بالعبسنة) من تحرش يومي بإسرائيل وقواها ، إذ لا يهاجم إلا معسكرات جيش إسرائيل ومواقعه ومنشآته، ليس معزولا، كما يبدو، عما يخطط له حلفاؤه الشرقيون. ومن يدري إذا لم تتسع الحرب، فتتحول إقليمية، وتؤدي إلى قصقصة اجنحة العدوانية الإسرائيلية، بعد تحجيم النفوذ الأميركي في المشرق وخلق منطقة أكثر أمانا – خصوصا وان ليس كل قادة إسرائيل على دين نتنياهو.
جدير بـ”سيادته” تغيير الديسك في دماغه، والنظر بإمعان إلى الواقع الجديد، الذي راح يتكون تدريجيا – عله يجد خشبة خلاص ويساهم بشيء ما يفيد فلسطين وأهلها. سياسة التسول السياسي، التي مشى الرجل على خطاها طويلا، أفلست، ولا مناص من استبدالها – أو، بعكس ذلك، الهلاك معها.
رغم سواد الليل الحالك، المطبق علينا حاليا، يبدو أن الفجر قريب. والأرجح أن يكون فجرا من نوع آخر.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=67861