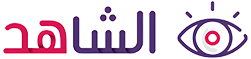ماذا لو انتصرت “إسرائيل”؟

رام الله – الشاهد| خط أستاذ الدراسات الصهيونية في جامعة القاهرة أحمد الجندي مقالاً، تحدث فيه عن السيناريوهات المتوقعة في حال انتصر الاحتلال في حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني واللبناني ومقاومتيه، والتي دخلت عامها الثاني قبل أسابيع، وانعكاس ذلك على الشرق الأوسط بمجمله. وفيما يلي نص المقال.
تتعرّض “إسرائيل” منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” لتهديد وجودي حقيقي، دفعها لتسخير قدراتها كلها، معتمدة بالأساس على الولايات المتحدة وأوروبا، من أجل تحويل هذا التهديد إلى فرصة حقيقية لإعادة تشكيل المنطقة ورسمها من جديد وفق معطيات تتوافق مع إرادتها ورغباتها، وتتماشى تماما مع حلم ما يعرف بالشرق الأوسط الجديد، الذي طالما بشّر به قادة ومفكّرون إسرائيليون، وهو حلم يتماهى مع الرؤية الأميركية التي طرحت ضمن ما أطلق عليه الساسة الأميركيون نظرية الفوضى الخلاقة، منذ أكثر من عقدين، لإعادة ترتيب الشرق الأوسط.
وتسعى إسرائيل عبر سلاح جو غاشم، ومخازن أسلحة أميركية مفتوحة من دون قيود، للقضاء على المقاومة في غزة، وفي لبنان؛ بل والتهديد بتغيير النظام الإيراني نفسه، وليس تدمير مشروعها النووي، ولا تدمير منشآتها النفطية فحسب، وهو ما دفع الصحافي الإنكليزي بول وود أن يعنون مقاله المنشور في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مجلة سبكتاتور “إسرائيل تعيد رسم الشرق الأوسط لصالحها”.
وهنا تحديدا يمكن الزعم بأن خروج إسرائيل من الحرب الحالية منتصرة، لو حدث، قد يحقق لدول ما يعرف بمعسكر الاعتدال العربي أمنياتها في التخلص من المقاومة، بل ربما من النظام الإيراني نفسه، لكنه سيحولها إلى دول تابعة، ليس لدولة بحجم الولايات المتحدة هذه المرة، بل لدولة صغيرة، بلا تاريخ، أو ديموغرافيا تؤهلها لهندسة المنطقة ولعب دور الشرطي، أو بالأحرى دور البلطجي، الذي ستتركه الولايات المتحدة لها لو تمكنتا معا من حسم الصراع في المنطقة لصالحهما.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن وجود قطبين عالميين كان يحمي مصالح الدول الضعيفة التي لا تريد امتلاك أسباب القوة، أو تحيا بلا مشروع حقيقي. وينطبق هذا المنطق على المستويات الإقليمية أيضا؛ بمعنى أن وجود إيران وقوى المقاومة، وإن اعتبرته بعض الأنظمة العربية تهديدا، هو أحد عوامل تحقيق التوازن في المنطقة في مواجهة الكيان الصهيوني المتغطرس، في ظل تخلي العرب عن أي دور قيادي، وتبعيتهم الكاملة للولايات المتحدة.
ولا شك أن قيام الثورة الإسلامية في إيران، وتحول نظرة دول الخليج لها بوصفها عدوا رئيسا، كان أحد الأسباب التي دفعت أكثرها للتوجه نحو إسرائيل، بشكل متدرج، وعبر علاقات سرية استمرت لعقود طويلة ثم تحولت بشكل تدريجي إلى علاقات معلنة، وصلت لمستويات من التعاون غير المسبوق خلال العقدين الأخيرين؛ والذي فتح أبواب التعاون الاستخباري بين إسرائيل ودول الخليج، وقاد إلى اختراق الكيان الصهيوني لمنظومات أمن هذه الدول من خلال إسناد مشروعات كبرى بمليارات الدولارات لشركات إسرائيلية في مجالات حساسة لمراقبة الطرق، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتجسس على المعارضين.. وغيرها.
ولا أظن أن أحدا يمكن أن يختلف حول أن العرب في هذا الواقع الجديد “المفترض” سيكونون تابعين للمشروع الصهيوني الأوسع للسيطرة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصبح إسرائيل العقل والإدارة، ويكون دور العرب التنفيذ والتمويل والتبعية. وقد عبرت خطة شمعون بيرس حول الشرق الأوسط الجديد عن هذا التوجه منذ أطلقها شمعون بيرس في بدايات التسعينيات من القرن الماضي.
وفي الشهور الماضية، اتسعت الرؤية لتأخذ عنوان “MENA 2050 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2050” وهو تصور طموح ممول من قبل مؤسسات صهيونية أميركية، بل ورجال أعمال عرب، حسب مقال نشر في صحيفة يديعوت أحرونوت في يوليو/تموز الماضي، ويقود المشروع العقيد السابق في الجيش الصهيوني، إيلي بار أون، الذي يقوم بدور الرئيس التنفيذي. ولا ينظر لهذا المشروع على أنه دعوة للتعايش، بل محاولة لرسم مستقبل الشرق الأوسط في عام 2050، ويضم، وفقا للمقال، مئات العراقيين واللبنانيين والأردنيين والمصريين والسعوديين والسوريين واليمنيين والليبيين والأتراك والتونسيين والمغاربة والكويتيين والبحرينيين والإماراتيين والفلسطينيين، بعضهم صحافيون كبار ورؤساء تحرير صحف خليجية.
وحسب كلام بار أون، فإن التحالف للمعتدلين في المنطقة “الذين يريدون قيادة معركة ضد التطرف في الإقليم”. اللافت في هذا المشروع الصهيوني أنه لا يطرح بوصفه مشروعا سياسيا، بل للاهتمام بالتعليم والطاقة وتغير المناخ وتمكين المرأة.. بمعنى أنه يقدم أجندة صهيونية، تسعى لتجميع المؤمنين بهذه الفكرة تحت سقف واحد بعيدا عن شبكات التواصل الاجتماعي التي تروج للتطرف الذي لا يرضي الإسرائيليين.
وليس غريبا تعمّد بعض الأصوات العربية المشاركة تضييق مفهوم الصراع ضد إسرائيل، من كونه عربيا إسرائيليا، ليصبح فلسطينيا إسرائيليا، بل يتخطى الأمر ذلك إلى ضرورة عدم الحديث عن ماهية هذا الصراع حتى لا يكون عاملا معوقا. وهذا يعني التماهي التام مع الفكرة الإسرائيلية في تهميش القضية الفلسطينية، بل وأن ينظر إليها بوصفها عبئا في طريق تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهو مستوى أبعد بكثير من مجرد تطبيع العلاقات، يصل إلى حد تشارك نفس النظرة حول تعريف الإرهاب وتحديد من هم الإرهابيون، وهنا بالطبع تدخل حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، والحوثيون في اليمن، وحركات الإسلام السياسي، إضافة إلى إيران في قلب هذا التصنيف.
وهكذا تذهب رؤية عرب الاعتدال بعيدا؛ لأنها حين تصف المقاومة وإيران بالإرهاب، تستبعد، قصدا أو سهوا، النظر إلى إسرائيل على أنها كيان عسكري إرهابي، ويتم التركيز على تقدمها التكنولوجي، واعتبارها كيانا له ثقافة وجذور في المنطقة، وليسوا غرباء عنها. وإذا كان التقدم التكنولوجي لدولة الاحتلال أمرا منطقيا لأنها امتداد غربي، فإن الزعم بتجذّر هؤلاء المستوطنين في المنطقة، والادعاء أنهم أصحاب ثقافة وجذور فيها أمر يخالف المنطق والحقيقة التاريخية، وينم عن جهل مطلق، وانسحاق أمام كيان صهيوني طارئ.
وتعتقد إسرائيل أيضا بإمكانية لعب دور قيادي في حفظ الأمن الملاحي في البحر الأحمر؛ وكان معهد دراسات الأمن القومي نشر، في 9 أكتوبر الحالي، مقالا مطولا بعنوان “إسرائيل في البحر الأحمر؛ من التهديد إلى التعاون” لعدد من باحثيه، رأوا أن الخسائر التي تتعرض لها الدول العربية المطلة على البحر الأحمر تمثل فرصة يمكن أن تستغلها إسرائيل للاضطلاع بهذا الدور القيادي؛ فمصر مثلا تتعرض لخسائر تقدر بـ 600 مليون دولار شهريا نتيجة تراجع أعداد السفن التي تمر عبر قناة السويس، بسبب موقف الحوثيين من الحرب في غزة، كما تتضرر كذلك الدول التي تصدر نفطها وبضائعها عبر هذا الممر الملاحي.
وإذا كانت دولة الاحتلال لا تطل على البحر الأحمر إلا بساحل صغير، وميناء وحيد هو ميناء إيلات، فضلا عن عدم امتلاكها أسطولا عسكريا بحريا كافيا للاضطلاع بهذا الدور القيادي، فإنها تعتمد على إمكاناتها التكنولوجية والاستخبارية، وتعول أكثر على المساهمة الأميركية الكبيرة من خلال القيادة المركزية الأميركية في المنطقة CENTCOM، وعلى تعاون مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تأسس عام 2020، وعلى التعاون غير الرسمي مع الدول “المعتدلة” والذي يضم إسرائيل، وتم توسعته بعد اتفاق أبراهام.
إذا انتقلنا لما سيتبقى من القضية الفلسطينية، فمن الضروري العودة بالذاكرة إلى العوامل التي قادت إلى اتفاق أوسلو؛ حيث جاء الاتفاق إثر انتفاضة الحجارة في عام 87، وحينها بنيت نظرية الأمن الإسرائيلية على إنشاء سلطة فلسطينية تقوم بالتنسيق الأمني مع الأجهزة الإسرائيلية، وقمع أي نشاط فلسطيني مقاوم. وعلى هذا الأساس، وخلال العقود الماضية، كانت مراكز الأبحاث في الكيان الصهيوني تحذر من سلوك حكومات نتنياهو المتعاقبة مع السلطة الفلسطينية، ومخاطر أن يؤدي إضعافها إلى كفر الفلسطينيين بالمسار السياسي والمفاوضات، واتفاق أوسلو، وهذا يعني زيادة في تأييد العمل العسكري ضد إسرائيل وصعود المقاومة.
ومن هنا فإن التخلص من المقاومة، إن تم، سيعني مباشرة زوال الأسباب التي أدّت إلى نشأة السلطة الفلسطينية، وربما لن تكون هناك حاجة لوجودها. خصوصا وأن الأنظمة العربية التي دعمت إسرائيل على التخلص من المقاومة، أو شجعتها سرا على إنجاز مهمتها في غزة، أو تعاونت عبر صمتها، في أحسن الأحوال، لن تقف في وجه إسرائيل إذا قرّرت التخلص من اتفاق أوسلو، الذي لم يتبق منه سوى التنسيق الأمني، في ظل مجتمع يزداد تطرفا يوما بعد يوم، وحكومة يمينية متطرفة تتبنى مكوناتها، سرا أو علنا، الدعوة للاستيطان في غزّة، وتسريع الاستيطان في الضفة الغربية، وطرد الفلسطينيين وإلقاء مشكلتهم على دول الجوار العربي.
لا تقتصر الخسائر المحتملة، في حالة انتصار إسرائيل، على مستوى الدول، فالأرجح أنها ستطاول حركات وجماعات وقوى رافضة للمشروع الصهيوني، وتمتد إلى كل المجالات التي يمكن أن نتخيلها. وهكذا فإن نهاية الحرب الحالية لصالح الكيان الصهيوني ستكون لها عواقب وخيمة على شعوب المنطقة، وتؤدي إلى تقزيم دول صاحبة تاريخ وجغرافيا وديموغرافيا، لصالح مشروع صهيوني لا يملك أصحابه مقدرات وطن عربي كبير. وبذلك فإن أي انتصار لهذا الكيان لن تكون نتيجته هزيمة المقاومة فحسب، بل خضوعا عربيا للمشروع الصهيوني، ومن هنا، وفي ظل حربٍ تعمل إسرائيل على جعلها فرصة لقيادة المنطقة وإخضاعها، لا ينبغي أن تكون هزيمة المقاومة خياراً.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=77736