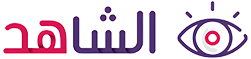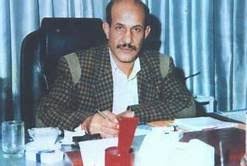السلام الاقتصادي.. منظومة استعمارية

رام الله – الشاهد| كتب حسين عبيد.. منذ توقيع اتّفاق أوسلو، رُسم للفلسطينيين مسارٌ جديدٌ نحو ما قيل إنّه الدولة، لكن عبر الأمن والاقتصاد لا عبر التحرر. سُمّي ذلك بـ”السلام الاقتصادي”؛ نهجٌ يستبدل شعارات المقاومة بمؤشرات النمو، ويحوّل ساحات المواجهة إلى مراكز تسوّقٍ ومشاريع إسكان.
هنا يجد المرء صدىً لوصف إدوارد سعيد لاتّفاق أوسلو بأنه “فرساي فلسطينية”، إذ رأى أنّه حمّل الفلسطينيين التزاماتٍ ثقيلةٍ، مثل التنسيق الأمني، ووقف المقاومة المسلحة، والاعتراف بدولة الاحتلال، من دون منحهم دولةً معترفًا بها، وفي الوقت نفسه وفّر للاحتلال شرعيةً دوليةً لإدارة التبعية. وفي إطار “السلام الاقتصادي”، يصبح المعنى أكثر وضوحًا، فهو لم يهدف إلى إنهاء السيطرة الإسرائيلية، بل إلى إدارة حياة الفلسطينيين داخل حدود هذه السيطرة، عبر السماح بقدرٍ من النشاط الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، وفق شروطٍ يضعها الاحتلال دومًا، وبطريقةٍ تضمن بقاء منظومته الاستعمارية مستقرةً ومحصنةً من أيّ تهديدٍ حقيقيٍ.
كشف السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تلاه من إبادةٍ وإغلاقٍ وحصارٍ، حدود وهم “السلام الاقتصادي” الذي رُوّج له منذ أوسلو. في أيّامٍ معدودةٍ، أُغلقت المعابر، جُمّدت أموال المقاصة، وتوقفت تصاريح العمل، فتوقفت عجلة الحياة الاقتصادية كما لو أنّها أُطفئت بزرٍ واحدٍ.
إعادة إنتاج التبعية من خلال “السلام الاقتصادي”
تاريخيًا، برز مفهوم “السلام الاقتصادي” في الخطاب السياسي جزءًا من تصوّرات تشكيل الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة، وكان شمعون بيريز من أبرز منظريه عبر رؤيته لـ”شرق أوسطٍ جديدٍ” يقوم على التكامل الاقتصادي الإقليمي، والاستثمار المفتوح، على غرار النموذج الأوروبي. اعتبر بيريز أن التعاون الاقتصادي والتكنولوجي يُنتج مصالح مشتركةً تمهّد لعلاقاتٍ سياسيةٍ، واقترح معالجة القضايا المعقدة كقضية اللاجئين الفلسطينيين عبر توطينهم في دول اللجوء، ومنحهم جنسياتها، مع مساهمةٍ إسرائيليةٍ في تمويل مشاريع لتحسين أوضاعهم المعيشية.
بعد ذلك، نشأ خطاب السلام الاقتصادي مكوّنًا مركزيًا في السياسات الدولية تجاه القضية الفلسطينية، إذ تبلور عبر تقارير البنك الدولي، وبرنامج “استثمار في السلام”، وكذلك من خلال توقيع بروتوكول باريس 1994. بناءً على ذلك؛ تدفقت أموال المانحين، والمشاريع الاستثمارية، ونُظمت مؤتمرات المانحين ومشاريع “بناء الدولة” التي قادها خبراء من أمثال توني بلير وغيره بعد 2007، وفي عام 2008، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض العالم لحضور حفلٍ استثماريٍ ضخمٍ في الضفّة الغربية حيث خاطب المشاركين بقوله:
“نحن نقيم حفلًا، والعالم كله مدعو. هذا المؤتمر فرصة لإظهار وجه مختلف لفلسطين، فلسطين مواتية للنمو الاقتصادي والاستثمار الدولي. أرحب بكم في فلسطين لتستمتعوا بكرم ضيافتنا، وتتعرفوا عن كثب إلى إمكانية ممارسة الأعمال التجارية في فلسطين”.
كان الاعتقاد السائد أن ضخّ الأموال وبناء المؤسسات سيوفّران عائدًا ملموسًا للسلام يُقنع الفلسطينيين بجدوى التسوية السياسية. لكن تبيّن أنّ ما سُمّي بالسلام الاقتصادي هو ترسّيخٌ لآلياتٍ اقتصاديةٍ وقانونيةٍ ربطت السوق الفلسطيني بالإسرائيلي، وجعلت السياسات المالية والجمركية مرهونةً بشروط الاحتلال. كما أعاد إنتاج تبعياتٍ هيكليةٍ وطبقيةٍ تحت ستار التنمية، وأضفى على الاحتلال صيغًا ناعمةً من الهيمنة عبر القوانين والمؤسسات والتمويل الدولي بدلًا من أن يقود إلى زواله. من هنا ترسخت لدى صُنّاع القرار الإسرائيليين قناعةٌ بأن شراء الهدوء بالمال أمرٌ ممكنٌ، أيّ أنّ التطلعات الوطنية الفلسطينية يمكن احتواؤها عبر السلام الاقتصادي عوضًا عن الحلول السياسية.
رافق التبعية للاحتلال تحوّلٌ نحو اقتصاد السوق الحر، ولم يكن هذا خيارًا للسلطة الفلسطينية، بل نتيجة ضغوطٍ دوليةٍ من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، اللذين فرضا سياساتٍ ماليةً هدفت إلى تقليل دور السلطة في الاقتصاد، ودعما سياسات الإصلاح الهيكلي، التي ركّزت على تعزيز الاستثمارات الخاصة بدلًا من تطوير قطاعٍ عامٍ قويٍ.
أدّت ترتيبات أوسلو وما تلاها من سياسات السلام الاقتصادي إلى إعادة صياغة العلاقة بين المجتمع الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي على صعدٍ عدّة. فعلى الصعيد السياسي، أفرز أوسلو سلطةً فلسطينيةً ذات حكمٍ ذاتيٍ محدودٍ، تعتمد في بقائها ووظائفها على التنسيق مع إسرائيل، وعلى تمويل المانحين. في هذا الإطار، جرى إعلاء الاعتبارات الأمنية على الحسابات الوطنية؛ إذ أصبح على السلطة الفلسطينية إثبات قدرتها على ضبط الأمن، ومنع المقاومة لضمان استمرار تدفّق الدعم الاقتصادي. هكذا حلّ منطق “الأمن مقابل الاقتصاد” عمليًا محلّ الشعار القديم “الأرض مقابل السلام”. وبعد الانتفاضة الثانية (2000–2005)، تعزّز هذا النهج مع إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدعمٍ أميركيٍ–أوروبيٍ، وتحويلها إلى قواتٍ مدرَّبةٍ على ضبط الأوضاع الداخلية، وملاحقة المقاومة بذريعة “فرض النظام وسيادة القانون”، تمهيدًا لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية. بذلك أصبح التنسيق الأمني الركن السياسي المحوري لنموذج السلام الاقتصادي.
هندسةٌ طبقيةٌ تمكِّن الاحتلال
مثّل السلام الاقتصادي آليةً منهجيةً لإعادة هندسة البنية الاجتماعية الفلسطينية؛ إذ أعاد هذا النموذج رسم مواقع الفئات المختلفة وعلاقاتها بالسلطة والاحتلال، مفرزًا طبقاتٍ جديدةً ومرسِّخًا التفاوتات القائمة، وهو ما يتضح عند تحليل أبرز هذه الفئات وتحولاتها.
تمثّل التحوّل الأوّل والأكثر استراتيجية بعد أوسلو في نشوء شبكة زبائنية كمبرادورية ربطت بين رأس المال المحلي من جهةٍ، والسلطة الفلسطينية والمانحين الدوليين من جهةٍ أخرى. وقد أفرزت هذه الشبكة رجال أعمال ارتبطوا بالسلطة وحصلوا عبرها على عقودٍ احتكاريةٍ في قطاعاتٍ حيويةٍ مثل الاتصالات، والبناء والاستيراد والتوزيع. ومع الوقت، لم تعد هذه الامتيازات مجرد نشاطٍ اقتصاديٍ، بل تحوّلت إلى أداةٍ سياسيةٍ تُستخدم لضمان الاستقرار الداخلي؛ ولإدامة هذا الترتيب، جرى تثبيت الامتيازات بقوانين وسياسات خصخصةٍ، ما جعلها جزءًا من البنية الرسمية. هكذا، أصبح جزءٌ من النخبة الفلسطينية شريكًا مباشرًا في إدارة منظومة الاحتلال الاقتصادي بدلًا من مواجهتها، ليغدو الحفاظ على مصالحهم الخاصّة سببًا لتغليب الاستقرار على حساب المقاومة.
التحول الثاني يتعلق بالعاملين في مؤسسات المجتمع المدني والمنظّمات الدولية، إذ شكّلوا فئةً مركبةً: فهم مهنيون يملكون معرفةً إداريةً وشبكاتٍ تمويليةً دوليةً، ما مكنهم من أن يكونوا حلقةً وسيطةً بين المانحين والمجتمع الفلسطيني، لكنهم ساهموا أيضًا في تجريد العمل المدني من طابعه السياسي، وتحويله إلى قطاعٍ خدميٍ تابعٍ لمؤشرات التنمية.
التحول الثالث: موظفو السلطة، موظفون حكوميون لديهم رواتب ثابتة ومخصصاتٍ، مثل القطاع الأمني والتعليمي والصحي، اعتمادهم المالي على الرواتب التي تأتي من المانحين وبعض العوائد الضريبية.
التحول الرابع: يضم ضحايا “السلام الاقتصادي”، وما فرضه من إعادة تشكيلٍ للبنية الاجتماعية الفلسطينية. من أبرز هؤلاء الضحايا العمال والمزارعون الذي يتوزعون على فئاتٍ عدّة: عمالٌ يوميون وموسميون يتنقلون للعمل داخل إسرائيل بتصاريح محدودة أو عبر وسطاء، وعمال بناء ومصانع يعملون بعقودٍ قصيرةٍ أو باليومية، وصغار المزارعين الذين يملكون مساحاتٍ صغيرةٍ من الأراضي الزراعية، ويعتمدون على المحاصيل الموسمية، وعمال زراعيون بلا أرض يعتمدون على تشغيلٍ مؤقتٍ. وقد كانت هذه الفئات الأكثر تعرضًا للهشاشة، إذ شكّل موقعها في الاقتصاد المعاد ترتيبه مرآةً لتأثيرات هذا النموذج على الأرض والإنتاج المحلي.
هناك طبقةٌ وسطى حضرية، معظم الأوقات هي مديونةٌ، تعتمد على القروض، وتتعرض للإفقار بسبب سياسات الاحتلال المجحفة، خاصّةً بعد السابع من أكتوبر.
أنتج تفاعل البرجوازية الكمبرادورية مع السلطة، وتهميش العمال والمزارعين والحرفيين نظامًا اقتصاديًا يفضّل قطاعات الخدمات والعقارات على القطاعات الإنتاجية التقليدية، ما أدى إلى تراجع الصناعة والزراعة المحلية أمام تدفّق السلع الإسرائيلية، وسياسات السوق المفتوح، واندثار المشروعات الصغيرة، وتحويل جزءٍ كبيرٍ من العمال إلى فائض قيمةٍ لصالح سوق الاحتلال. وأحدثت مشاريع التطوير وتراخيص الاستثمار تحولاتٍ جوهريةً في العلاقة مع الأرض، من خلال تحويل أراضٍ ريفيةٍ إلى مشروعاتٍ سكنيةٍ وتجاريةٍ، ما دفع المزارعين إلى العمل خارج قطاعهم. ونتج عن ذلك أثرٌ اقتصاديٌ واجتماعيٌ مزدوج: تراجعٌ واسعٌ في القدرة الإنتاجية المحلية، وزيادة هشاشة الفئات المهمشة، وإضعاف شبكات الضمان الاجتماعي.
مجتمع المشهد في رام الله
يرى الشاعر والكاتب والسينمائي الفرنسي غي ديبور، في كتابه “مجتمع المشهد” الصادر عام 1967، أنّ الرأسمالية لم تعد تسيطر عبر الإنتاج المادي فقط، بل أيضًا من خلال إنتاج الصور والتمثيلات التي تفرض على الناس طريقةً محددةً لرؤية العالم. فـ’المشهد’ ليس مجرد صور أو دعاية، بل هو علاقةٌ اجتماعيةٌ متوسَّطةٌ بالصور؛ أي أنّ العلاقات الاجتماعية نفسها باتت تمر عبر الصور والرموز بدلًا من أن تكون مباشرة.
إذا أردنا تطبيق ذلك على مدينة رام الله، فإنّها لم تعد تُعرَّف من خلال نضالها أو ارتباطها المباشر بالأرض والمقاومة، بل بات كثيرون يعرّفونها من خلال صورتها مدينةً بأبراجٍ زجاجيةٍ ومقاهٍ ومراكز تسوّق. بعد أوسلو، يمكن فهم رام الله بوصفها “مدينة مشهدٍ” بالمعنى الذي صاغه غي ديبور؛ إذ تحوّلت فضاءاتها الحضرية إلى واجهةٍ نيوليبرالية مبهرة، أبراجٍ زجاجيةٍ، مقاهٍ عالميةٍ، مراكز تسوّق، ومهرجاناتٍ ثقافية، تُسوَّق رمزًا لحداثةٍ فلسطينيةٍ قيد التكوين. غير أنّ هذا المشهد يعمل قناعًا أيديولوجيًا يخفي البنية الاستعمارية العنيفة، التي ما زالت تحاصر المدينة بالمستوطنات والحواجز، وتصادر أراضي قراها المحيطة. بذلك، أصبحت رام الله تستهلك صورتها أكثر مما تنتج سيادتها.
تمثّل مدينة روابي، الواقعة شمال رام الله، نموذجًا توضيحيًا لما نرمي إليه؛ إذ يتحوّل العمران والاستهلاك فيها إلى صورةٍ جماعيةٍ مُدارةٍ بعنايةٍ أكثر من كونهما واقعًا اجتماعيًا تحرريًا. فهي تجسّد تكثيفًا للمشهدية النيوليبرالية التي تفصل بين ساكني “المدينة الحديثة” وبين المخيّمات والقرى التي بقيت خارج هذه التجربة.
مدينة المشهد في رام الله، لا تغطي على واقع الاحتلال وحسب، بل تمتد لتحجب تاريخها النضالي الراسخ في الوعي الجمعي الفلسطيني. فقبل أوسلو، كانت المدينة مركزًا حيويًا للانتفاضة الأولى (1987–1993)، إذ قاد طلابها ونقابيوها وعمالها موجاتٍ من الإضرابات والتظاهرات الحاشدة التي رسّخت صورتها فضاءً للمقاومة الشعبية. أما بعد أوسلو، وعلى الرغم من تحوّلها إلى مقرٍ إداريٍ للسلطة الفلسطينية، وواجهةٍ حضريةٍ نيوليبرالية، ظلّت رام الله ومعها القرى المحيطة، مثل بلعين ونعلين والنبي صالح، بؤرًا دينامية للمقاومة ضدّ الجدار والاستيطان.
تؤّكد الأحداث الأخيرة بعد السابع من أكتوبر 2023 استمرار هذا النسيج المقاوم لريف رام الله، فقد وثقت منسّقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) العديد من اعتداءات المستوطنين التي أسفرت عن مئات الجرحى، وعشرات الشهداء من الفلسطينيين. تركزت معظم الإصابات شمال شرق رام الله، في مناطق مثل دير ديبوان، والمزرعة الشرقية، وسلواد، وسِنجل، وبيتين، وكفر مالك وقرى أخرى مجاورة. كما شهد مخيّم المغيّر طردًا قسريًا لعائلةٍ بدويةٍ، وازدادت هجمات قطعان المستوطنين على قرى غرب رام الله، إضافةً إلى تدمير ممتلكات الفلسطينيين. هذه الوقائع تجسد المفارقة بين واجهة المدينة الحداثية والتخوم الريفية التي هي في اشتباكٍ مستمرٍ مع الاحتلال، وتدفع أثمانًا من أراضيظها ودماء أبنائها.
من التنمية المزعومة إلى سياسة الموت
الاستنتاج المركزي هنا؛ أنّ ما أُطلق عليه “السلام الاقتصادي” في فلسطين لم يكن مجرد سياسةٍ اقتصاديةٍ، بل أصبح أداةً تنظيميةً أعادت تشكيل العلاقة بين الاحتلال والسلطة والمجتمع والفرد. فهو منظومةٌ متعددة المستويات: قانونيةٌ عبر بروتوكول باريس الاقتصادي، ومؤسساتيةٌ عبر المانحين ومؤسسات المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية، وفضائيةٌ من خلال مشروعاتٍ مثل “روابي”، ونفسيةٌ-سلوكيةٌ عبر السعي إلى إنتاج المواطن-المستهلك/المُقترض.
بعد السابع من أكتوبر2023، بات واضحًا أن ما يُسمّى بـ”السلام الاقتصادي” قد تحوّل؛ أو ربّما كان الهدف منه منذ البداية، إلى تجسيدٍ لما وصفه المفكر الكاميروني أشيل مبمبه في عمله Necropolitics (2003) بـ”النيكروبوليتيك”، أي سياسة الموت، التي تمنح السلطة الاستعمارية الحقّ في تقرير من يعيش ومن يموت باستخدام أدواتٍ متعددةٍ. في السياق الفلسطيني، ظهر الاقتصاد أداةً من أدوات الاحتلال للتحكم في حياة الناس وإخضاعهم، وإبادتهم وتهجيرهم، من خلال إغلاق المعابر أو فتحها، إصدار التصاريح أو سحبها، تحويل عائدات الضرائب أو تجميدها، وقطع الإمدادات الأساسية، الوقود والكهرباء والغذاء، وصولًا إلى التجويع المتعمد في قطاع غزّة. هذه الآليات كلّها تحوّل الاقتصاد إلى وسيلةٍ لخنق المجتمع أو إبقائه على قيد الحياة وفق شروط الاحتلال، أو إبادته.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=93096